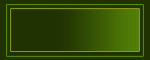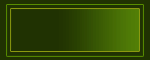- من هو محمد رسول الله؟
- السيرة النبوية
- نبوءات بظهور الرسول
- رسالة لمن لايؤمن برسول الله
- الرسول زوجا
- أصحاب الرسول
- كيف تتبع رسول الله
- انصر نبيك وغض بصرك
- شبهات و ردود
- معجزات الرسول
- نحن و الرسول
- قرأنا لك عن رسول الله
- مدح رسول الله
- أطفالنا على خطى رسول الله
- أخبار الموقع
- اصدارات الموقع
- شاركنا في حملات الموقع
- إنضم إلينا
| تحت قسم | أعمال القلوب | |||
| الكاتب | د. شيلان محمد علي القرداغي | |||
| تاريخ الاضافة | 2017-08-01 21:06:59 | |||
| المشاهدات | 713 | |||
|
|
|
|
ساهم فى دعم الموقع |
|
لطالما قرأنا في القرآن قَصصَ الدعوة والدعاة من الأنبياء والرسل والصالحين، وتأثَّرنا كثيرًا بعناد الطغاة والجبابرة؛ بل ذُهِلْنا مِن مواقف الكفار وشدةِ عنادهم وتعسُّفهم، وعلى الجانب الآخر رأينا نماذجَ مثالية من حُبِّ الله والثبات على طريق الدعوة بالرغم من كل المعوِّقات والعداوات. ولكن الذي يجعلنا نقف ساعات مَلِيًّا بعدَ أنْ عَقَدَ التعجبُ لسانَنا هو ما نراه من مواقف الأَوبةِ إلى الحقِّ بعد سنواتٍ عِجافٍ في التِّيهِ والضلال، وهنا نرُومُ ذِكرَ أنموذجين رائعين لسرعة دخول الإيمان في قلوب مَن ظلُّوا في الكفر سنواتٍ وسنواتٍ، وهما: سحَرة فرعون، وملِكة سبأ. إن إيمانهم لم يكن إيمانًا عاديًّا كإيمان باقي البشر الذين هداهم الله بأنْ يدعوهم الأنبياء، ويمهِّدوا لهم طريق القناعة إلى الإيمان، ثم يُظهِروا لهم المعجزاتِ فيؤمنوا. فسحَرةُ موسى كانوا يرجُون نَوال فرعونَ، ويحلُمون بقربه؛ كما دوَّن لنا القرآن الكريم حالَهم هذا بقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ * قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ [الأعراف: 113، 114]. بيد أنهم لمَّا لاح لهم الحقُ وانجلى، تركوا ما ألْـفَوا عليه آباءَهم، وأصبحوا في حالةٍ إيمانية نادرة؛ بل إنَّهم تَرَقَّوا إلى مرتبةٍ مِن الفناء في سبيل الله عز وجل؛ بحيث تتطاول لها أعناقُ المؤمنين، وأضْحَوا في لحظاتٍ قليلةٍ في سِلك أوليائه بعدما كانوا في خانة أعدائه، وأصبحوا أنيسَ الحق وتِرْبَه بعد أن كانوا غريمه وخصمه، فها هو فرعون الطاغية لما يرى أوبتهم إلى الحق، يبدأ بتهديدهم بكل ما أوتي من جبروت وطغيان؛ علَّهم يعودون إلى ضلالهم القديم، ويقول لهم كما جاء في سورة طه: ﴿ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ [طه: 71]، ولكن تهديده هذا لم يجد منهم آذانًا مصغيةً؛ بل زادهم إصرارًا وتمسُّكًا بالحق الذي دخل شَغاف قلوبِهم ووجدوا حلاوته، وصعَقوا فرعون بقولهم: ﴿ لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه: 72، 73]. أما بلقيس، فإنها كانت ملِكةً على سبأ، ولها عرشها العظيم، وأوتيت من كل شيء؛ لكنَّ بريقَ الدنيا وزهرتَها، وعِزَّ الجلوس على العرش وجبروتَه - لم يَحُولا دونَ الخضوعِ للحق لمَّا سطعت شمسُه في سماء الإيمان، فآمَنَت وأسلَمَت مؤثِرةً الآخرةَ على الأولى، ثم إنها فَورَ إيمانها وَقَفَت جَنْبًا إلى جنب مع سيدنا سليمان عليه السلام، وأصبحتْ في صَفِّ هذا الرسول الجليل، وأعلنت البقاء إلى جنبه في الدعوة إلى الله، وأضحت جنديَّة مخلصةً في سبيل الدعوة بعدما كانت ملكة ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [النمل: 44]. فما سبب هذا الإيمان السريع؟ بل الأهم ما سبب دخول الإيمان إلى قلوبهم؟ ومِن أين لهم هذه المعرفة الحقيقية بالذات الإلهية، وهم لم يسمعوا شيئًا من الدعوة إلى الله؟ إنَّ سرعة إيمانِ سَحَرةِ موسى وملكةِ سبأ دليلٌ على أنَّ مَن وصل مبلغًا عاليًا من العلم أو المُلك؛ فإنَّه ينبغي أنْ يعلم أنه بحاجة إلى إلهٍ قدير يكون له سندًا وعونًا وملجأً. معظم هؤلاء يعلمون حقيقةَ آلهتهم التي يعكُفُون عليها صُمًّا وعميانًا، يعلمون أنها آلهةٌ وهمية ينخدع بها البسطاء؛ أما من أوتي شيئًا من العلم، فإنه وإن أظهر إيمانَه بهم فإنه في داخله لا يفتر يبحث عن إلهٍ فيه صفاتُ الربوبية والألوهية بأكمل وجه، إلهٍ تكون قدرته فوق قدرة وتصوُّر الذين حولهم، وهذا ما لمَسه السحرةُ في دين موسى، فهم يعلمون حقيقة السِّحر وما يعلمه الكهنة، ولكنهم صُدموا بما فعله موسى، وعلموا حقَّ اليقين أن هذا ليس بسحر؛ بل هو من صنع مَن خَلَق السحرة؛ فهو القادر على تغيير جوهر الأشياء من شيء إلى شيء آخرَ. كذلك ملكة سبأ؛ فإنها قد أوتيت من كل شيء، ولا تحتاج إلى شيء دنيويٍّ؛ ولكنها أحَسَّت بنقصٍ وفراغٍ رُوحي، وشعرت بحاجتها لِمَا يملؤُه. فغنى بلقيس ماديًّا لم يسدَّ لها هذا الفراغَ، وهذا ما جعلها تفكِّر في حقيقة الوجود، فالمحتاج دائمًا يفكر في كيفية الحصول على حاجته، وقد يشغله هذا عن الرُّقِيِّ للتفكير في الخالق؛ بل يربط حاجته بالحاجيات الدنيوية والأشخاص العاديين. أما من كانت حاجة الناس إليه، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه عاجز، فإنَّه يُحسِن التفكيرَ في حقيقة الوجود والإيجاد أكثرَ من غيره. وعند هاتين النقطتين كان المنعطَفُ الصعب الذي غَيَّر حياةَ فئتين مختلفتين من الناس: فئةٍ قد أوتيت العلم، وفئة قد أوتيت الحُكْم. فما كان منهما إلا أن أذْعَنا لحكم ربِّ العالمين في العباد بعبادته. ولكنَّ تساؤلًا يفرض نفسه الآن: هل إنَّ كلَّ مَن آتاه اللهُ العلمَ أو الحُكمَ أو كليهما من الممكن أن يؤمن حينَ يرى الأدلة على حقيقة وجود الله؟ بالطبع لا؛ فإن الكِبْر إنْ وُجِد في القلب؛ فإنه يكون مانعًا من الاعتراف والإيمان بالله؛ كما قال تعالى عنهم في سورة الأعراف: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ [الأعراف: 146]، فها هو فرعون قد آتاه الله الحُكمَ ففرض نفسَه إلهًا على قومه؛ فنراه يقول كما في سورة النازعات: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [النازعات: 24]، وفي الوقت نفسه حين يبتليه الله بالآيات التِّسع المتتالية، فإنه يُهرع إلى موسى عليه السلام، ويطلب منه أن يدعوَ ربَّه ليرفع عنهم الغُمَّة؛ أي: إنه يعلم جيدًا أن ربَّ موسى إلهٌ حقيقي. فهو عالمٌ أنه ليس بإله، وهو يعلم كذلك أنَّ ربَّ موسى عليه الصلاة والسلام هو الإله الحق، ومع ذلك يقول: ﴿ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الزخرف: 51]؛ أي: إنه قد اغترَّ بمُلكه، فماذا كانت نتيجة هذا الحاكم العالمِ؟! إنه بقي كافرًا طيلةَ حياته، ولم يعلن إسلامه إلا لحظة موته غرقًا؛ وذلك ليقينه السابق أنَّ ربَّ موسى عليه السلام هو الإله الحق، وقد ظنَّ أن الله سينجيه هذه المرة أيضًا كما أنجاه من ﴿ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ﴾ [الأعراف: 133]. ولكن الله عزَّ وجلَّ يمهل ولا يهمل، وهيهات أن ينجيَه بعدما أمهله سنواتٍ؛ فأهلكه الله ومن معه وأغرقهم أجمعين، وأبقى جسدَه عبرةً خالدةً لكل جبارٍ متكبِّرٍ في الأرض. نسأل الله أن يهبنا علمًا ينفعنا في الدنيا والآخرة، ومُلكًا نَخدُم به دينَه ورسالتَه، ونسأله أن يجنِّبنا الغرور والكبر والرياء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
المقال السابق المقال التالى
أضف تعليق