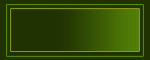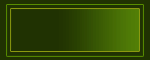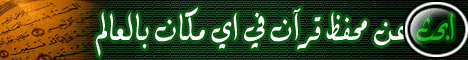- من هو محمد رسول الله؟
- السيرة النبوية
- نبوءات بظهور الرسول
- رسالة لمن لايؤمن برسول الله
- الرسول زوجا
- أصحاب الرسول
- كيف تتبع رسول الله
- انصر نبيك وغض بصرك
- شبهات و ردود
- معجزات الرسول
- نحن و الرسول
- قرأنا لك عن رسول الله
- مدح رسول الله
- أطفالنا على خطى رسول الله
- أخبار الموقع
- اصدارات الموقع
- شاركنا في حملات الموقع
- إنضم إلينا
| تحت قسم | الرسول المعلم وأساليبه في التعليم _ عبد الفتاح أبو غُدّة | |||
| تاريخ الاضافة | 2011-02-24 00:35:33 | |||
| المشاهدات | 2211 | |||
|
|
|
|
ساهم فى دعم الموقع |
|
لَفْتُه صلى الله عليه وسلم السائلَ إلى غير ما سَأَل عنه
وتارةً كان صلى الله عليه وسلم يَلفِتُ السائلَ عن سؤالِه لحكمةٍ بالغةٍ ومن ذلك :
ما رواه البخاري ومسلم6، واللفظُ للبخاري ، عن انسٍ رضي الله عنه ((أنَّ رجلاً قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم : متى الساعةُ يا رسولَ الله؟ قال : ما أعددتَّ لها؟ قال : ما أعددتَّ لها من كثيرِ صلاةٍ ولا صومٍ ولا صَدَقةٍ ، ولكني أحبُّ الله ورسولَه ، قال : أنت مع من أحببتَ)) .
فلَفَتَه صلى الله عليه وسلم عن سؤالِه عن وَقْتِ قيام الساعة ، الذي اختَصَّ الله تعالى بعلمِه ، إلى شيءٍ آخَرَ هو أحوجُ إليه ، وأفضَلُ نفعاً عليه ، وهو إعدادُ العملِ الصالح للسّاعةِ ، فقال : ما أعددتَّ لها؟ فقال : حُبَّ اللهِ ورسولِه ، فقال : أنت مع من أحببتَ .
فزاده صلى الله عليه وسلم أياً أن الإنسان يُحشَرُ مع من يُصاحِبُ ويُحبُّ . وفي هذا تبصيرٌ للإنسان وتحذيرٌ من أن يتَّخذ في الدنيا قريناً له غيرَ صالحٍ ، فيكونَ معه في الآخرةِ حيث يكون!
وهذا الأسلوبُ في لَفْتِ السائل يُسمّى : أسلوبَ الحكيمِ ، وهو تَلَقّي السائلِ بغير ما يَطلُب ، مما يَهُمُّه أو مما هو أهمُّ مما سأَل عنه أو أنفَعُ له .
ومن هذا الباب أيضاً ما رواه البخاري ومسلم7:
عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أنَّ رجلاً سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ما يَلْبَسُ المُحْرِم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَلْبَسُ القَميصَ ، ولا العِمامةَ ، ولا السَّراويلَ ، ولا البُرْنُسَ ، ولا ثوباً مسَّهُ الوَرْسُ أو الزَّعْفرانُ ، فإنْ لم يَجِد النَّعلَيْنِ ، فلْيَلْبَسْ الخُفَّين ، ولْيَقْطَعْهُما حتى يكونا تحت الكعبينِ)) .
فأنت ترى أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عما يَلْبَسُ المُحْرِم ، فأجاب ببيانِ ما لا يَلبَسه المُحرِم ، وتَضمَّن ذلك الجوابَ عما يَلْبَسُه ، فإنَّ ما لا يَلبَسُه المُحْرم محصور ، وما يَلبَسُه غير محصور ، فعدَل عما لا ينحصرُ تعدادُه إلى ما ينحصر ، طلباً للإيجاز ، ولو عدَّدَ له ما يلبَسُ لطال به البيان ، وربما يَصعُبُ على السائل ضبطُه واستيعابُه .
ثم بيَّن له صلى الله عليه وسلم زيادةً عما سأل : حُكمَ لُبسِ الخُفِّ عند عدَمِ وجودِ النَّعْل ، فزاده بيانَ حالةِ الاضطرار هذه ، وهي مما يتصل بالسؤال ، فقال : ((فإنْ لم يجد النَّعْلَين ، فلْيَلْبَسْ الخُفَّين ، ولْيَقْطَعْهُما حتى يكونا تحت الكعبين)) . ومن هذا القبيل أيضاً :
ما رواه البخاري ومسلم1، واللفظُ له ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : ((أنَّ رجلاً أعرابياً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله : الرجلُ يُقاتِلُ للمَغْنَم ، والرجلُ يُقاتِلُ لِيُذكَر2، والرجلُ يُقاتِلُ لِيُرى مَكانُه3، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من قاتل لتكونَ كلمةُ اللهِ أعلى4فهو في سبيل الله))5.
ففي هذا الحديث عُدولُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم عن الجواب عن عينِ ما سألَ السائلُ عنه إلى غيره ، إذْ كان لا يصلح أن يُجاب عما سأل عنه بنعم أو : لا ، فقد عدَلَ عن جوابه عن ماهِيّةِ القتالِ التي يَسأل عنها ، إلى بيان حالِ المُقاتِل ، وأفاده أن العِبرةَ بخُلوص النية والقصد .
وفي إجابةِ الرسول صلى الله عليه وسلم بما ذَكَر ـ ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)) ـ غايةُ البلاغة والإيجاز .
وقد عُدَّ هذا الحديثُ من جوامع كَلِمِه صلى الله عليه وسلم ، لأنه لو أجاب بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل الله ، احتَمَل أنَّ ما عدا ذلك كلُّه في سبيل الله ، وليس كذلك ، وقد يكون الغضبُ والحميةُ لله تعالى فيكون ذلك في سبيل الله ، فعَدَل صلى الله عليه وسلم إلى لفظ جامع لمعنى السؤال والزيادةِ عليه ، فأفاد دَفْعَ الالتباس وزيادةَ الإفهام .
-----------------------------------------
6 ـ البخاري 7 :40 في كتاب المناقب (باب مناقب عمر بن الخطاب) ، و10 :463 في كتاب الأدب (باب علامة الحب في الله) ، و13 :116 في كتاب الأحكام (باب القضاء والفتيا في الطريق) ، ومسلم 16 :185 في كتاب البر والصلة (باب المرء مع من أحب) .
7 ـ البخاري 1 :203 ـ 204 في كتاب العلم ، (باب من أجاب السائلَ بأكثر مما سأله) ومسلم 8 :73 في كتاب الحج .
1 ـ البخاري 1 :197 في كتاب العلم (باب من سأل ـ وهو قائم ـ عالماً جالساً) ، و6 :21 في كتاب الجهاد (باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) ، و159 باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره . ومسلم 13 :49 في كتاب الإمارة (باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) .
2 ـ أي ليُذكَر بين الناس بالشجاعة والبطولة .
3 ـ أي ليُريَ الناسَ أنه شجاع قوي . فمرجع هذا الفعل إلى الرياء ، ومرجع الفعل الذي قبله إلى السُّمْعة والشهرة ، وكلاهما مذموم . وفي رواية عند البخاري 1 :197 ((ويُقاتِلُ غَضَباً)) أي لأجل حظّ نفسِه . ((ويقاتل حَمِيّةً)) أي لمن يقاتل لأجله ، من أهلٍ أو عشيرة أو صاحبٍ أو جار .
ولما كان كل من هذه المقاصد في القتال تناوله المدح والذم بحسب الباعث الأول ، لم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنَعَمْ أو لا . قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) 6 :22 : ((فإذا كان أصلُ الباعثِ الصِّرْفِ على القتال هو إعلاءَ كلمة الله ، فلا يَضرُّه ما عرَضَ له بعد ذلك ، والمحذور أن يَقصِدَ غير الإعلاء ـ قصداً أولياً ـ .
ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمناً ، لا يَقدحُ في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعثَ الأصلي : ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حَوالة ، قال : بَعَثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أقدامنا لنغنم ، فرجعنا ولم نغنم شيئاً . فقال : اللهم لا تَكِلهم إليَّ فأضعُفَ عنهم ، ولا تَكِلهم إلى أنفسهم فيَعجِزوا عنها الحديث)) . انتهى .
4 ـ هكذا رواية مسلم . ورواية البخاري : (لتكون كلمةُ الله هي العُلْيا) .
و(العُليا) تأنيث (أعلى) . و(كلمةُ الله) هي دعوةُ الله إلى الإسلام ، ودينُه وشريعتُه .
5 ـ وفي هذا الحديث من الامور التعليمية : جوازُ سؤال المتعلم عن علة الحكم ، لقوله : (فمن في سبيل الله؟) وتقديمُ تحصيل العلم على الدخول في العمل ، إذ المطلوب من المسلم أن يعلم ثم يعمل ، ليكون عمله على بصيرة وهدى من الشرع الحنيف .
المقال السابق المقال التالى
أضف تعليق