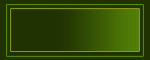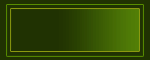- من هو محمد رسول الله؟
- السيرة النبوية
- نبوءات بظهور الرسول
- رسالة لمن لايؤمن برسول الله
- الرسول زوجا
- أصحاب الرسول
- كيف تتبع رسول الله
- انصر نبيك وغض بصرك
- شبهات و ردود
- معجزات الرسول
- نحن و الرسول
- قرأنا لك عن رسول الله
- مدح رسول الله
- أطفالنا على خطى رسول الله
- أخبار الموقع
- اصدارات الموقع
- شاركنا في حملات الموقع
- إنضم إلينا
| تحت قسم | الجزء الثاني_زاد المعاد | |||
| تاريخ الاضافة | 2007-11-26 03:25:16 | |||
| المشاهدات | 2381 | |||
|
|
|
|
ساهم فى دعم الموقع |
|
فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد
وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله ( وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ) ( آل عمران 121 ) إلى تمام ستين آية فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك كما قال تعالى (ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ) ( آل عمران 152 ) فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاؤوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة ومنها أن هذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتموه قال نعم قال كيف الحرب بينكم وبينه قال سجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا فاقتضت حكمه الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه وظهرت مخباتهم وعاد تلويحهم تصريحا وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم
قال الله تعالى ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء) ( آل عمران 179 ) أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء فإنهم متميزون في غيبه وعلمه وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة وقوله ( ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ) استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه كما قال ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ) ( الجن 27 ) فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط فهو المدبر لأمر عباده كما يليق ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والا نكسار قال تعالى ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ) ( آل عمران 123 )
وقال ( ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ) ( التوبة 25 ) فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره ومنها انه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ) ( آل عمران 139 , 140 ) فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال ( إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ) ( آل عمران 140 ) فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب كما قال ( إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ) ( النساء 104 ) فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا
ثم ذكر حكمة أخرى وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحسن ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء فإنه يحب الشهداء من عباده وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها وقد اتخذهم لنفسه فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة وقوله ( والله لا يحب الظالمين ) ( آل عمران 139 ) تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يجبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم وهو تمحيص الذين آمنوا وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم فحصل له تمحيصان تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه فقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) ( آل عمران 142 ) أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه بالجنة فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم فإن الله لا يجزى العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه فقال ( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ) ( آل عمران 143 )
قال ابن عباس ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم فأراهم الله ذلك يوم أحد وسببه لهم فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم فأنزل الله تعالى ( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ) ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله أو قتل بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به فكل نفس ذائقة الموت وما بعث محمد ليخلد لا هو ولا هم بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله أو بقي ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل فقال (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ) ( آل عمران 144 ) والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله وارتد من ارتد على عقبيه وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا وأن تنوعت أسبابه ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى فريق في الجنة وفريق في السعير ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا ما استكانوا وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا وما استكانوا بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما ثم أخبر سبحانه عما اسنتصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم فقال (وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين) ( آل عمران 147 )
لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها وأنها نوعان تقصير في حق أو تجاوز لحد وأن النصرة منوطة بالطاعة قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا هم على يثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا فوفوا المقامين حقهما مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين فمن والاه فهو المنصور ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله وعلى قدر الشرك يكون الرعب فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا والذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح والمشرك له الخوف والضلال والشقاء ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ذلك كله وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين قيل للحسن كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوه فقال لولا عفوه عنهم لا ستأصلهم ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم
ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض أو صاعدين في الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم والرسول يدعوهم في أخراهم إلي عباد الله أنا رسول الله فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم غم الهزيمة والكسرة وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل وقيل جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوه فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه والقول الأول أظهر لوجوده أحدها أن قوله ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ) تنبيه على حكمة هذا الغم من بعد الغم وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح فنسوا بذلك السبب وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر الثاني أنه مطابق للواقع فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة ثم أعقبه غم الهزيمة ثم غم الجراح التي أصابتهم ثم غم القتل ثم غم سماعهم أن رسول الله قد قتل ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم وليس المراد غمين اثنين خاصة بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب لا أنه سبب جزاء الثواب والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم وأصحابه وترك استجابتهم له وهو يدعوهم ومخالفتهم له في لزوم مركزهم وتنازعهم في الأمر وفشلهم وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل فترتب عليها آثارها المكروهة فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها وربما صحت الأجسام بالعلل ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن كما أنزله عليهم يوم بدر وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية
وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمه له فيه ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون والمشركات به سبحانه وتعالى في سورة الفتح حيث يقول ( ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدلهم جهنم وساءت مصيرا ) ( الفتح 6 ) وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون فمن ظن بالله ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمه بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا ( ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) ( ص 27 ) وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف
موجب حمده وحكمته فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي تؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به وانما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان فقد ظن به ظن السوء فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى والحق وهذا من أسوإ الظن الله فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية
ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقط ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقول به وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يجب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين وقد استنفد ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء
ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه فقد ظن بن ظن السوء ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل أعداءهم عليهم أبدا أو أنه لا يقدر على ذلك بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر أو أنه غير قادر على ذلك فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده وذلك من ظن السوء به ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك لكن رفوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه واستجاروا من الرمضاء بالنار فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه فإنه لا يقدر على أفعال عباده ولا هي داخلة تحت قدرته فظنوا بن ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم وكل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستذل فهو يظن بربه هذا الظن وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو في خصومه فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به وأنه كان يبنغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم في ذلك
( فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة % وإلا فإني لا إخالك ناجيا )
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله تعالى وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم فهي أولى يظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأفعاله كذلك كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل وأسماؤه كلها حسنى
( فلا تظنن بربك ظن سوء % فإن الله أولى بالجميل )
( ولا تظنن بنفسك قط خيرا % وكيف بظالم جان جهول )
( وقل يا نفس مأوى كل سوء % أيرجى الخير من ميت بخيل )
( وظن بنفسك السوآى تجدها % كذاك وخيرها كالمستحيل )
( وما بك من تقى فيها وخير % فتلك مواهب الرب الجليل )
( وليس بها ولا منها ولكن % من الرحمن فاشكر للدليل )
والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله ( وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ) ( آل عمران 154 ) ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو قولهم ( هل لنا من الأمر من شيء ) ( آل عمران 154 ) وقولهم ( لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ) ( آل عمران 154 ) فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليه بقوله ( قل إن الأمر كله لله ) ( آل عمران ) ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل ها هنا هو التكذيب بالقدر وظنهم أن الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل ولكان النصر والظفر لهم فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء فأكذبهم الله بقوله ( قل إن الأمر كله لله ) فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به علمه وكتابه السابق وما شاء الله كان ولا بد شاء الناس أم أبوا وما لم يشأ لم يكن شاءه الناس أم لم يشاؤوه وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بد سواء كان لهم من الأمر شيء أو لم يكن وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشأوه الله وأن يشاء ما لا يقع
فصل
ثم أخبر سبحان عن حكمة أخرى في هذا التقدير هي ابتلاء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا ايمانا وتسليما والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه ثم ذكر حكمة أخرى وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصة وتنقيته وتهذبيه فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبة بإزالته وتنقيته من جسده وإلا خيف عليه من الفساد والهلاك فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه ولا بد فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها ويبعث إليه سرته تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه فأعمال العبد تسوقه قسرا إلى مقتضاها من الخير والشر والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به ثم أخبر سبحانه أنه عفا عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك وإنما كان عارضا عفا الله عنه فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها
ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم فقال ( أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ) ( آل عمران 165 ) وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية فقال ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) ( الشورى 30 ) وقال ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) ( النساء 79 ) فالحسنة والسيئة هاهنا النعمة والمصيبة فالنعمة من الله من بها عليك والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك فالأول فضله والثاني عدله والعبد يتقلب بين فضله وعدله جار عليه فضله ماض في حكمه عدل فيه قضاؤه وختم الآية الأولى بقوله ( إن الله على كل شيء قدير ) بعد قوله ( قل هو من عند أنفسكم ) إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر وفي ذلك إثبات القدرة والسبب فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر فهو يشاكل قوله ( لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشأوون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) ( الانسان 30 ) وفي ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكلوا على سواه وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله ( وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ) وهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني كقوله في السحر ( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) ( البقرة 102 ) ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزا ظاهرا وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة ونعمة على المؤمنين سابغة وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما
ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدعاها إلى الرضى بما قضاه لها فقال ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ( آل عمران 169 ) فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده وجريان الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما آتاهم من فضله وهو فوق الرضى بل هو كمال الرضى واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة ولم يبق لها أثر البتة وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى ومن الشقاء إلى الفلاح ومن الظلمة إلى النور ومن الجهل إلى العلم فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير فأعملهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته وسلاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز وجلاله
فصل
ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الذراري والأموال فشق ذلك عليهم فقال النبي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها قال علي فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم موعدكم الموسم ببدر فقال النبي قولوا نعم قد فعلنا قال أبو سفيان فذلكم الموعد ثم انصرف هو وأصحابه فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم فبلغ ذلك رسول الله فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال فقال له عبدالله بن أبي أركب معك قال لا فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف وقالوا سمعا وطاعة واستأذنه جابر بن عبدالله وقال يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معك فأذن له فسار رسول الله والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله فأسلم فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه فقال ما وراءك يا معبد فقال محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم فقال ما تقول فقال ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم قال فلا نفعل فإني لك ناصح فرجعوا على أعقابهم إلى مكة ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة فقال هل لك أن تبلغ محمدا رسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة قال نعم قال أبلغ محمدا أنا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه فلما بلغهم قولهم قالوا ( حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ) ( آل عمران 174 )
فصل
وكانت وقعة أحد يوم السبت في سابع شوال سنة ثلاث كما تقدم فرجع رسول الله إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعها يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله فبعث أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه مائة وخمسين رجلا من الأنصار والمهاجرين فأصابوا إبلاء وشاء ولم يلقوا كيدا فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة
فصل
فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي قد جمع له الجموع فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله قال عبد المؤمن بن خلف وجاءه برأسه فوضعه بين يديه فأعطاه عصا فقال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه وكانت غيبته ثمان عشرة ليلة وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم فلما كان صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة وذكروا أن فيهم إسلاما وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن فبعث معهم ستة نفر في قول ابن إسحاق وقال البخاري كانوا عشرة وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي وفيهم خبيب بن عدي فذهبوا معهم فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا فجاؤوا حتى أحاطوا بهم فقتلوا عامتهم واستأسروا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فذهبوا بهما وباعوهما بمكة وكانا قتلا من رؤوسهم يوم بدر فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا قتله فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين فتركوه فصلاهما فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا ان ما بي جزع لزدت ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا ثم قال
( لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا % قبائلهم واستجمعوا كل مجمع )
( وكلهم مبدي العداوة جاهد % علي لأني في وثاق بمضيع )
( وقد قربوا أبناءهم ونساءهم % وقربت من جذع طويل ممنع )
( إلى الله أشكوا غربتي بعد كربتي % وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي )
( فذا العرش صبرني على ما يراد بي % فقد بضعوا لحمي وقدياس مطمعي )
( وقد خيروني الكفر والموت دونه % فقد ذرفت عيناي من غير مجزع )
( وما بي حذرا الموت إني لميت % وإن إلى ربي إيابي ومرجعي )
( ولست أبالي حين أقتل مسلما % على أي شق كان في الله مضجعي )
( وذلك في ذات الإله وإن يشأ % يبارك على أوصال شلو ممزع )
( فلست بمبد للعدو تخشعا % ولا جزعا إني إلى الله مرجعي )
فصل
وفي هذا الشهر بعينه وهو صفر من السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد فقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبونهم فقال إني أخاف عليهم أهل نجد فقال أبو براء أنا جار لهم فبعث معه أربعين رجلا في قول ابن إسحاق وفي الصحيح أنهم كانوا سبعين والذي في الصحيح هو الصحيح وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعنق ليموت وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال فزت ورب الكعبة ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان فجاؤوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد بن النجار فإنه ارتث بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسلمين فرأيا الطير تحوم على موضع الوقعة فنزل المنذر بن محمد فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه وأسر عمرو ابن أمية الضمري فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه عن رقبه كانت على أمه
ورجع عمرو بن أمية فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة وجاء رجلان من بني كلاب فنزلا معه فلما ناما فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه وإذا معهما عهد من رسول الله لم يشعر به فلما قدم أخبر رسول الله بما فعل فقال لقد قتلت قتيلين لأدينهما فكان هذا سبب غزوة بني النضير فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه وبينهم من الحلف فقالوا نعم وجلس هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه فاجتمع اليهود وتشاوروا وقالوا من رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هموا به فنهض رسول الله من وقته راجعا إلى المدينة ثم تجهز وخرج بنفسه لحربهم فحاصرهم ست ليال واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وذلك في ربيع الأول قال ابن حزم وحينئذ حرمت الخمر ونزلوا على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح ويرحلون من ديارهم فترحل أكابرهم كحيي ابن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر وذهبت طائفة منهم إلى الشام وأسلم م
المقال السابق المقال التالى
أضف تعليق