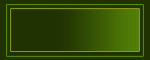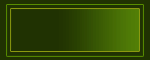- من هو محمد رسول الله؟
- السيرة النبوية
- نبوءات بظهور الرسول
- رسالة لمن لايؤمن برسول الله
- الرسول زوجا
- أصحاب الرسول
- كيف تتبع رسول الله
- انصر نبيك وغض بصرك
- شبهات و ردود
- معجزات الرسول
- نحن و الرسول
- قرأنا لك عن رسول الله
- مدح رسول الله
- أطفالنا على خطى رسول الله
- أخبار الموقع
- اصدارات الموقع
- شاركنا في حملات الموقع
- إنضم إلينا
| تحت قسم | أعمال القلوب | |||
| الكاتب | يحيى بن علي الزهراني | |||
| تاريخ الاضافة | 2017-09-06 23:06:57 | |||
| المشاهدات | 610 | |||
|
|
|
|
ساهم فى دعم الموقع |
|
وإذا ذُكِر الصفا انصرف الفؤادُ مُتيِّما للبلد الحرام مكة، فثمَّ: تصفو النفوسُ وتنجلي.. عنها من الأوهام والآثامِ.. فقريبٌ من الصفا الكعبة، والمطاف، والمقام، وزمزم والمسعى، ويقابل المروةَ الصفا، فـ لله ما أعظم تلك البقاع، وما أجل النعمة بالقرب منها، والتوفيق للعمل الصالح، فالصفا من الصفاء وهو النقاء، فحَرِيٌّ بمن طاف وسعى، ووحّد الرب العظيم وكبّرا، أن يصفو قلبُه، وتُغسل خطيئته، ويعود من حجه كيوم أمُّه ولدته، فخذ - يا أُخي -
|
سوانح الفكرِ الذي سطرتُه
واستر بأخلاق الكرامِ قصورا
الفقه أن ترعى الحلالَ تورّعا
لا أن تُعمّر.. منزلاً وقصورا
|
﴿ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ﴾ [النحل: 94] أُعيذك اللهَ من الإدبار بعد الإقبال، فالعبد لا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نُهبةً يرفع الناسُ إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، فهذا نفي كمال الإيمان الواجب كما ترى، فهو طعْن في إيمانهم، وقدْح في مروءتهم، وربّ قبيلةٍ يرفع الناسُ لها هموهم وقضاياهم وحاجاتهم، أصلحتْ دهراً، وأفسدتْ يوماً، حُفِظ خطؤها ونُسِي جميلُها، والدنيا تفتن، والمال وحب الذكر ورؤية النفس والسعي لغلبة الرأي وتخطئة الآخرين.. أمور لا يكاد ينفك منها مَن خالط حُبُّ الدنيا قلبَه، وغلب التعلقُ بها الرغبةَ فيما عند الله، أوليس الحرص على الدنيا أهلك من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا؟ واعلم علّمك العليم، أن نبينا الرحيم صلى الله عليه وسلم، بدأ في دعوته الإصلاحية بأقرب الناس إليه، ثم بقية قرابته، ثم عمّم الدعوة، فمن أراد إصلاحا أو وأْد فساد فليقتدِ بهذا الهدي، فيبدأ بنفسه قبل أن يُرشد غيره، فيكون عاملا بعلمه، صادقا عند رهطه، حري بالإجابة والامتثال لمن يدعوهم.. وإذا استبانَ لك هذا، رأيتَ أنه هدْيُ سائر أنبياء الله عليهم السلام، فهم الصفوة من الخلق فـ ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الحج: 75]، إذ يعملون بما يعلمون، ويأمرون أهليهم ومَن ولاهم اللهُ عليهم وينهون، وقد نادى نوحٌ ابنه من قبل: ﴿ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ [هود: 42] فسبيل المصلحين في كل زمان ومكان، يأمرون الناسَ ولا ينسون أنفسهم، وغيرهم يأمرون ﴿ النَّاسَ بِالْبِرِّ ﴾ [البقرة: 44] وينسون أنفسهم؛ إما كبرا وأشرا، وإما جهلا وحمقا، وإما ظلما وعُلُوّا، وكلها ﴿ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ [النور: 40] فاخْتَرْ لنفسك أيّ هدْيٍ تطلبُ *** فسبيلُ ربي واضحُ الأركانِ وحين صعِد المصطفى الصفا هتف: وأجمل بذاك الصوت من صوتٍ *** صوتِ به الخيرُ يأتي من مسافاتِ اجتمعوا، إذْ كانتِ العرب أبيّة أصيلة تُجيب الصارخ، وتجير المستجير، وتنصر المستغيث، حتى إن مَن لم يستطع الخروج أرسل رسولا، وهذه صفة كانتْ في العرب وبقية في الإسلام، حيث لو أُريد جمْعهم، نُودي: الصلاة جامعة، فاجتمعوا، وهذه إحدى مفقودات اليوم، مذخورات الأمس، تطلعات الغد.. وانظر إلى صدق اللسان، ونصح القلب، والحرص على هداية الخلق: "اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئًا"، والله جل في علاه يقول: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: 56]، أي هداية توفيق، لا هداية دلالة وإرشاد، فقد أعذر إليهم، وأقام عليهم الحجة، ولم يكْتف بذلك بل تبعهم في أسواقهم ومجامعهم، يدعوهم للإسلام وترْك عبادة الأوثان.. وافهم فهّمك الحكيم، أن الإنسان إذا اشرأبّت إليه الأبصار وتطاولت له الأعناق، يُخشى عليه كثيرا من العجب ورؤية النفس، وأهل الدنيا الساعون لمناصبها الراكضون لمطامعها الحالمون بمسامعها إذا حكم أو جلس أحبّ أن يرى من نفسه فضلا على غيره، وأنه يستطيع ما لا يطيقون، ويقدر ما لا يقدرون، ورغّبهم في عطائه ووعدهم بنواله، حتى ترغب إليه الناسُ، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن طالب دنيا، ولا مريد منصب، ولا جامع مال، خالف كل ما اعتِيد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا!، والله يقول له: ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: 188].. اجتمع صلى الله عليه وسلم على الصفا، فنفروا منه، وقال الشقي البغي - وبئس ما قال -: تبًّا لك! ألهذا جمعتنا؟ فنزلتْ ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ [المسد: 1]، فما ضرّه نفرةُ مَن نفر، ولا زجر مَن زجر، بل واصل السيرَ في طريق الإصلاح ليلا ونهارا، سرا وجهارا.. وبين ندائه الأول: "اشتروا أنفسكم" والقوم أغلبهم لم يؤمنوا، وندائه الثاني: "..أنجز وعده، ونصر عبده.." و﴿ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾ [النصر: 2] سنوات من الصبر والدعوة ﴿ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: 125] وجهاد النفس وكل ما فيه غيظ أعداء الله وكسْر شوكتهم وإضعاف حوزتهم، من مقاطعة تجارية، وعقْد تحالفات، وتطهير الصف، ووأد الصدع، وتقوية الردع، فـ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ [التوبة: 111]، فكان ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ﴾ [الأحزاب: 23].. إن بداية الطريق نحو الإصلاح بدأ بشخص نبينا صلى الله عليه وسلم، فبدأ غريبا وما ضره شيئا، فما ثنته غربةُ البداية، فقد نصره اللهُ، وأظهره اللهُ، وأظهر به الدين، وأزهق الباطل ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: 81]، فالغريب ليس -دائم- ضعيفا، كما أن المشهور لا تعني الكثرة أن يكون -دائما- صحيحا، فهو الذي يقول لصاحبه ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: 40]، فلا يُقْعِدنّك كثرةُ المنكَر وقلة المنكِر، فالإسلام بدأ غريبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، ويُوشك الناسُ إذا رأوا المنكرَ ثم لم يأخذوا بيد صاحبه أن يعمهم العذاب.. حين صعِد الصفا استقبل الكعبة ودعا، وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، فتأمل هذا الذكر العظيم، وانظر هذا الموقف المهيب، وذلك الموقف العصيب، يوم قاموا عنه وتولوا الأدبار، فإن سنة الله ماضية في عز ونصر وتمكين أوليائه، فزبد الكفر والفسوق يضمحل ويذهب أمام ثبات وصحة الإيمان، فسنة في الحياة ﴿.. وَنَبْلُوكُمْ﴾ فإذا وقفتَ على الصفا، فاعلم أن الأمة كانت في ضلال وشرك وجاهلية وعمى، فأرسل اللهُ لهم محمدا، فأخرجهم الله من الظلمات إلى الهدى، وأسبغ عليهم النعمى، فاذْكُر بوقوفك على الصفا، كيف أن الله يُحيي الموتى، ويجعل لمن لا عز له ولا مقام منزلا وسؤددا، فمَن رام أن يدوم عزه، ويبقى سلطانه ويزيد ملكه فليستكثر من السُّنة وليعض عليها النواجذ، وليقم شرع الله في نفسه وأهله وقرابته والناس، وليحذر الظلم، وأعظمه أن تجعل لله ندًّا وهو خلَقك. وإذا رقيتَ الصفا وقلتَ: نصَر عبدَه، فاعلم أن نصر الله لأوليائه قريب، فلا تغتر بإمهال الله لك، فهي إما رحمة بك، لتتوب، أو استدراج لتُؤخذ على حين غرة، فالله الله أن يرفع العبدُ يديه مكبرا ومهللا، ولسان حاله: يا من نصرتَ عبدك محمدا انصر عبدك المظلوم إذْ ظُلِمَا، ولا تيأس من علاج مرضك الذي استعصى على البشر، أو فقرك الذي طال به العمر، أو عدوك الذي أوصد عنك السُّبل، فعلى الصفا مواطن الدعوات ومناهل الإجابات.. إن نبينا صلى الله عليه وسلم حذّر معاذاً -رضي الله عنه- من الظلم حين بعثه إلى اليمن، فقال: "وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" وهم أهل كتاب، فكيف بمن يظلم مَن يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله! فإني - يا أُخِي - لا آمَنُ عليك عذاب الله وانتقامه لأوليائه، ومن أكلتَ أموالهم، وضربت ظهورهم، وحبستهم، فدعوة المظلوم ولو كان كافرا ستجد بابا فاتحا، والله تعالى يقول: "يا عبادي! إني حرمتُ الظلمَ على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا". إنّ نداء المصطفى صلى الله عليه وسلم على الصفا، بدأ بأهم القضايا وأعظمها وأجلها، وهي إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، فكانت سنوات من التربية على مبدأ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 162] فمتى ما خلصت الأفعال كلها، أقوالا وأعمالا لله وحده، فقد وضعتِ الأمةُ قدمها في أُولى خطوات تصحيح المسار، وإذا فقِهتَ هذا فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وعالج كل ما يُريب حوله، حماية له، وتعظيما لربه، وتصفية لدينه، فالله تعالى يقول: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، مَن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركتُه وشرْكَه"، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن سمَّع سمَّعَ اللهُ به، ومن راءى راءى اللهُ به"، وقال: "أجعلتني لله نِدًّا؟". فإذا تبيّن لك هذا فاعلم أن الطوائف التي تزعم أنها على الحق، وتتبع السنة، وتريد الجنة قد كثرتْ، وتنوعّت أحزاباً وشِيعاً، وكلما قامتْ فرقة ضعف من الجماعة ما ضعف، واهتز من أركانها ما يفرح به العدو، وليس بضار أهل السنة والجماعة أن يأتي مَن يُخرجهم من قلادتهم ويكسوهم غير لباسهم، فإن ما يتعبّدون به ربهم هو اتباع الكتاب وسنة نبيهم، وكلما ضعُفت الدعوة لعقيدة التوحيد الخالص، فلا تعجب أن يتراقص - تعبّداً - هكذا يزعمون - نصارى اليوم، ممن ينتسب للإسلام، وهم أشد خطراً عليه ممن لا يعرفه أصلاً، وإن كان الجهل بالله ورسوله يجمع الفئتين، والله المستعان.. إن مَن نادى على الصفا، بـ "لا إله إلا الله وحده"، هو القائل: مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ"، أي مردود على صاحبه، وهو القائل: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضُّوا عليها بالنواجذ"، وهو القائل: "إن يطيعوا أبا بكر وعمر يَرْشُدُوا" وقال: "إنكم محشورون حفاة عراة غرلا.. وإنه سيُجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.. فيقال: إنهم لم يزالوا مُرتدِّين على أعقابهم" فمَن أراد الآخرة وسعي لها سعيها الذي شرعه الله وأتى به رسوله، وهو مؤمن مصدِّق فجزاؤه مشكور، وذنبه مغفور، ومن عصى واستكبر فقد أبى، والله يقول: ﴿ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: 19] أمة الإسلام، إن أمتنا غدتْ أضحوكة بين الأمم، وألعوبة بيد العجم، بأسها بينها شديد، وعقابها للكافرين بعيد، فأمة تجتمع على الصفا، كلها تلبي -بالتوحيد- وتنقّي عقيدتَها ممن كل ما يشوبها لهي أمة خير، ألا فاعلمي يا أمة الإسلام، أن اجتمع المسلمين في الحج يغيظ الكافرين، وودّوا لو تكفرون، فقبلة تجمع الأمة وهم في أصقاع الأرض، لحرِية بأن تُؤلفهم وهم بجوارها ويقصدون عينها، متى ما علِم اللهُ فيهم صدقاً ونصحاً وإخلاصاً.. يا أمة الإسلام، قبيل أعوام نادى عبدُ الله بن عبد العزيز - رحمه الله - باجتماع الفرقاء في فلسطين فاجتمعوا وعُقِد لهم صلحٌ فاصْطلحوا يومَها، وأمتنا اليوم أحوج ما تكون لاجتماع يجمع قادتها، ويُقوّي إرادتها، ويُعيد سيادتها، إن أمتنا أمة مرحومة، تجتمع في اليوم خمسا، وفي الحج حولا، وهي أمة الإصلاح والمصلحة، والشورى والمشورة، والمناصحة والنصيحة، حتى إنها لتدع المصلحة إن جلبت مفسدة، وأي مفسدة أعظم وأجل من افتراق الأمة وذهاب ريحها! إن أمتنا أمة مقدامة، حذرها القرآن من النكوص والخيانة، ﴿ فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ... ﴾ [الأنفال: 15، 16]، وتغنّى بذلك العرب، إذِ الإقدام للأبطال والإدبار للأنذال: فلَسْنَا على الأعقابِ تَدمَى كُلُومُنا *** ولكنْ على أقدامِنا تَقْطُرُ الدِّمَا يا أمة القرآن! الاختلاف في مواجهة العدو يكسر هيبة الفارس، ويدع الوقتَ له لاقتحام المتارس، ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 47] فأقِلّوا اللوم عاذل والعتاب، فالفرقاء إما إخوة أقارب، وإما حلفاء أباعد، والمرحلة تحتاج لتنازلات من كلٍّ، وإحجام من كلٍّ، ليدوم وِدٌّ، ويُرأب صدعٌ، وتجري مياه، فركودها إن لم يسلبها الطهورية تركها آسنة، عُرضة للهوام، وفيها ما لا يُطهِّره مع السبْع إلا التراب، كما أنه عُفِي عن يسير ما يُضاد الطهارة، فكم تحتاج الأمة لفقه "ألقوها وما حولها وكلوا"، والله يقول: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164]، ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ﴾ [المائدة: 2]، ومن الأحاديث التي يدور عليها الفقه في الدين "لا ضرر ولا ضِرار".. يا أمةً رقَتِ الصفا، جعلكِ اللهُ يا أمة الإسلام أمة وسطا، شاهدة على الأمم، مستخلَفة في الأرض، أُنيطتْ بك عظائم، أبتْ حملَها الرواسي، فالله أن تكوني في حقبتك هذه شر خلف لخير سلف، أو تكوني غالة أو مغلولة، أو ضالة أو متشبهة بالمغضوبة، فتحقيق: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: 6] يستلزم منكِ عملا جادًّا، تستوي فيه علانيتها وسرها، وكلمتها في رضاها وغضبها، وضعفها وقوتها، وإلا لركِبتْ سنن من كان قبلها، إذا سرق الشريفُ تُرِك وإن سرق الضعيف أُخِذ.. واحذري يا أمتنا الغلو، فإنه منبوذ، وكما التفريط منبوذ: ولا تَغْلُ في شيءٍ مِنَ الأمرِ واقْتَصِد *** كلا طرفي قصْدِ الأمورِ ذَمِيمُ "فدِينُ الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النمط الأوسط، الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين، ولم يلحقوا بغلو المعتدين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط، والآفات إنما تتطرّق إلى الأطراف، والأوساط محمية بأطرافها، فخيار الأمور أوساطها: كانتْ هي الوسطَ المحمِيَّ، فاكتنفتْ *** بها الحوادثُ حتى أصبحتْ طَرَفا" وأختم فأقول: إنّ الحمْل على كل ناصح ومخلص وأمين، بأنه متشدد، وخؤون، ومفسد، حملٌ فيه شُبْهةٌ، وانتفاؤه يجب أن يكون بتأصيلٍ لجاهل، وتربيةٍ لفاسد، ونصْحٍ لمتساهل، وإلا لعُطّلتْ شرائع، وعمّتْ مناكير، ووُثّق مجاهيل ووُهِّي ثقات، ولعادتْ بِدع يُراد لها ومنها أن تحيا في بلاد الإسلام لاسيما مهبط الوحي، كما أن الإفراط في النصح والحمْل كل الحمل على المخالِف أمر فيه خطر على الناصح والمنصوح، فأولاً لزوم السنة واتباع السُّبل السوية في الأخذ بيد من ضلّ السبيل "فإنما بُعثتم ميسرين ولم تُبعثوا معسِّرين"، مع غلبة الشفقة بمن أخطأ، لا أن يظهر الناصحُ على أنه أصلح وأتقى، وإذا ذُكِر الغلو فإياك والجفاء، إياك والإفراط والتفريط والتسويف، فإن التمادي في المعاصي والتهاون بالصغائر يُهوِّن أمر الكبائر، واتقاء محقرات الذنوب دليل خيرية العبد وخوفه وتقواه، يقول صلى الله عليه وسلم: مَن تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ".. واعلم بأنّ مَن جادل الأنبياءَ وخاصمهم وعاداهم وسعى في إفساد دعوتهم، وهو أصلح الخلق وأزكاهم، فما دونهم من باب أولى، فمن قال لنبيه ﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ [هود: 91]، ومن اتهمه بـ ﴿ سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴾ [ص: 4] فلا تعجب أن يرمي أهل الدعوة بما لا يليق من الأوصاف، ويوسمونهم بما يستقبح من الألقاب، ومن تطيّر بنبيّ فليتطيّرنا بداعية ومصلح، فلن تجتمع كأس وغانية ونصيحة وداعية في ساحة واحدة، أمَا رأيتَ الشيطانَ إذا سمع النداء أدبر وله ضراط حتى لا يسمع؟ ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 76] واللهَ اللهَ أن تعِظ أخاك وأنت متلبِّس بذنبه، أو معيِّرا له بخطئه، فكل بني آدم خطّاء وخيرهم التوابون، ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراما، ولعْن المؤمن كقتله، كما صح الحديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يتولاني وإياك بحفظه ورعايته، وأن يوفقنا لكل خير، ويفقّهنا في ديننا ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله المستعان، وهو حسبنا وعليه التكلان، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله العظيم.
المقال السابق المقال التالى
أضف تعليق