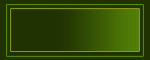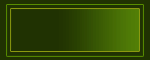- من هو محمد رسول الله؟
- السيرة النبوية
- نبوءات بظهور الرسول
- رسالة لمن لايؤمن برسول الله
- الرسول زوجا
- أصحاب الرسول
- كيف تتبع رسول الله
- انصر نبيك وغض بصرك
- شبهات و ردود
- معجزات الرسول
- نحن و الرسول
- قرأنا لك عن رسول الله
- مدح رسول الله
- أطفالنا على خطى رسول الله
- أخبار الموقع
- اصدارات الموقع
- شاركنا في حملات الموقع
- إنضم إلينا
| تحت قسم | أعمال القلوب | |||
| الكاتب | د. أمين الدميري | |||
| تاريخ الاضافة | 2017-07-29 22:17:43 | |||
| المشاهدات | 368 | |||
|
|
|
|
ساهم فى دعم الموقع |
|
قال سبحانه وتعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: 53]. إن تغيير أحوال الأمم، وتحويلَ النِّعم إلى نِقَم، والنِّقمِ إلى نعم، وسقوطَ الأمم وقيامها، وتبديل الرقي بالانحطاط، والانحطاط بالرقي - يخضع لقانون محكَم ثابتٍ، وسُنةٍ صارمة لا تعرف التهاونَ ولا المجاملة. لقد أنعم الله تعالى على قريش بأَنْعُمٍ كثيرة؛ منها نعمة الأمن والطمأنينة، ومنها الرزق الرغيد من كل مكان، ولكنهم لم يَشْكُروا، وجحَدوا نِعَم الله، وكفروا بالله الذي أطعمهم من جوع، وآمَنَهم من خوف، فتبدَّل الحال وتغيَّر الأمن فصار خوفًا، والغنى فقرًا، والإطعام جوعًا، قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ * وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [النحل: 112، 113]. يقول ابن كثير: (هذا مَثَلٌ أُريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنةً مطمئنةً مستقرَّة، يُتخطَّف الناس مِن حولها، ومَن دخلها كان آمنًا لا يخاف، ﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا ﴾؛ أي: هنيئًا سهلًا، ﴿ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ ﴾؛ أي: جَحَدَتْ آلاء اللهِ عليها، وأعظمُها بعثةُ محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾ [إبراهيم: 28]؛ ولهذا بدَّلهم الله بحالَيْهم الأوَّلَيْنِ خلافَهما، فقال: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾؛ أي: ألبسها وأذاقها "الجوع" بعد أن كان يُجبَى إليهم ثمرات كل شيء، ويأتيها رزقًا رغدًا من كل مكان، وذلك أنهم استعصَوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبَوا إلا خلافه، فدعا عليهم بسبعٍ كسبع يوسف، فأصابتهم سَنةٌ أذهبت كلَّ شيء لهم فأكلوا العلهز؛ وهو وَبَر البعير يُخلَط بدمه إذا نحَرُوه، وقولُه: ﴿ وَالْخَوْفِ ﴾، وذلك بأنهم بدلوا بأمنهم (في مكة) خوفًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة مِن سطوته وسراياه وجيوشه، وجعل كل ما لهم في دمار وسفال، حتى فتحها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم)[1]. فكان قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ ﴾ [الأنفال: 53] كالتعليل لحلول النكال؛ أي: إن ما حلَّ بقريشٍ خاضعٌ لسُنة مِن سنن الله تعالى، وهي أن زوال النعم مرتبطٌ بالكفران والنكران، بَيْدَ أن تغيير الحال مَنوطٌ بتغيير الأنفس، وأن بذور الرقي والانحطاط تنشأ وتولد في الأنفس؛ أي: إن سقوط أمم وقيام أمم، وزوال نِعَم وحلول نقم، أو العكس - يبدأ في الأنفس، فكأن الناس هم الذين قدَّموا لأنفسهم ورسموا مستقبل حياتهم ومماتهم، كما سبق في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [الأنفال: 51]، فإذا كانَتْ أمَّةٌ تعيش في رغدٍ مِن العيش وتَنعَم بالأمن والأمان، ثم دب فيها البَطَر والجحود ونكران النِّعَم، وتسرَّب إلى نفوس أهلِها حبُّ الدنيا والغرور، وعمِلت فيها جراثيم الكذبِ والخيانة والغش، وضياع الحقوق، والأنانية والشذوذ، وعدم الاكتراث والانتماء، وغير ذلك، ثم تسللت إلى أجساد الأمة أمراضُ الظلم وسوء الخلق - كان ذلك سببًا كافيًا لتغير الأحوال، وتبديل النعم إلى نقم، والأمن إلى خوف، والإطعام إلى جوع، والرقي إلى انحطاط وذَهاب الريح وسقوط الدولة، فالتغيير يبدأ أولًا مِن الداخل، ثم تظهر آثاره في الخارج بعد ذلك حسب درجة التغيير أو الانقلاب الداخلي، والعكس. على أن التغيير أو الانقلاب إلى الرقي أو الانحطاط له درجتانِ: الأولى: درجة الانقلاب الذهني والنفسي. والثانية: درجة الانقلاب العملي والخلقي. وبيان ذلك جاء في كتاب (النظام الإلهي للرقي والانحطاط)؛ كما يلي: (الأول: هو درجة الانقلاب الذهني والنفسي، ويتعلق بالتغيير الداخلي، الثاني: يتعلق بالتغيير الخارجي؛ أي: إن الأمة إذا تدرَّجت إلى الرقي، فإن إصلاح القوى الداخلية يتحقَّق في البداية، وتتغير الأفكار والأحاسيس والتصورات للحياة، ثم تنشأ (الجواهر) وتنمو، فتحقق صلاحية الحياة العملية بالتدريج، وحينما تصاب أمةٌ بالذل والنكبة، تفسد أولًا قُواها الداخلية، ويتغيَّر الفكر والنظر، ثم تنشأ الجراثيم التي تقضي على أهلية الحياة بالتدريج كذلك؛ أي: إن بقاء الأمة مرهونٌ بصلاحها (داخليًّا أولًا، ثم خارجيًّا بعد ذلك)، وفناءها مرهونٌ بفساد نفوسها أولًا، ثم فساد أعمالها بعد ذلك، فسُنة الله في خلقه أن الصالح يبقى؛ لأن فيه للبشرية نفعًا، وغير الصالح لا يبقي؛ لأنه لا نفع فيه، ويمكن أن تُوضِّح الآية التالية هذا المعنى، قال تعالى: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ [الرعد: 17]، وبما أن الماء والذَّهب والفِضة تنفع فإنها تبقى، والزبد الطافح غيرُ نافع فإنه يذهب، وعُلِم بهذا أن كل ما هو نافعٌ في الدنيا بوجه من الوجوه فالثباتُ له، وكل ما هو غير نافع، فإنه سائر إلى الفناء، وهذا هو "قانون البقاء للأنفع"، وعلى هذا، فإن الأساس الأصلي للرقي والانحطاط هو الأخلاق، فالأمة التي تتمسك بالأخلاق هي التي تستحق خلافة الله في الأرض، وهي التي تنفع الخلق حق النفع) [2]. إن قريشًا كانوا يعبُدون الأوثان، فأرسَل الله تعالى إليهم رسولًا منهم يَدعُوهم إلى عبادة الله تعالى وحدَه، فكفَروا به ولم يُصدِّقوه، إلا أن أمرَهم لم يقِفْ عند حدِّ الكفر والتكذيب، ولكنهم اعتَدَوا على صاحب الدعوة وأتباعه، فعذَّبوهم وطردوهم، وحاصروهم وضيقوا عليهم، واستولوا على أموالهم وممتلكاتهم، ثم تعقَّبوهم بعد ذلك، وأظهَروا البطر والرئاء، وصدُّوا عن سبيل الله، فكان في بقائهم فسادٌ وإفساد، وأضرارٌ وإضرار، فاستحال بقاؤهم، وتحتَّم زوالهم وتطهير الأرض منهم، وإراحة العباد من شرهم، وبدأ نجم المسلمين في الصعود؛ لأنهم آمنوا بالإله المعبود، والتزموا بأحسن الأخلاق والقيم. ومِن هنا؛ فإن الأخلاق السيِّئة هي أهم أسباب الانحطاط، ومن أهم أسباب الهلاك والإهلاك، وإن الأخلاق الحسنة هي أهم أسباب الرقي، ومن أهم أسباب التمكين في الأرض. ومن أهم الأخلاق السيئة التي يجب اجتنابُها والحذر منها: الشرك، والنفاق، والرئاء، والكِبْر، والعُجْب، والافتخار، والظلم، واتباع الهوى والملأ (السادة وعِلْيَة القوم) والشيطان، واتباع الباطل والشهوات، ودفع الحق ومحاربة أهله وصده، والعصبية، وغير ذلك[3]. ومن أهم الأخلاق الحسنة التي يجب الالتزام بها للرقي والمحافظة عليه ودوامه: العدل والمساواة بين البشر، (فلا تفاضل إلا بالتقوى والعمل الصالح، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: 13]، ومقاومة الفساد والمنكرات، وترك التنازع ونَبْذ الخلاف، والتعاون من أجل الخير والنصح، وغير ذلك من حميد الأخلاق. والسورة الكريمة ذكر فيها صفات أهل النصر والتمكين، ويمكن إجمالها فيما يلي: - تقوى الله عز وجل، إصلاح ذات البين، طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الله تعالى وتلاوة آياته، والتوكل على الله، وإقام الصلاة، والإنفاق من رزق الله، وعدم التولي يوم الزحف، وعدم التشبُّه بالكافرين، وعدم الخيانة والتعرُّض للفتنة، والصبر وترك التنازع، وترك البطر والرياء، والحذر من الشيطان ومن النفاق والمنافقين، ثم فَهْم سنن الله تعالى في الخلق، وأهمها سنن الرقي والانحطاط. ومن هنا؛ فإن على الدعاة إلى الله تعالى أن يلتزموا أولًا بتلك الأخلاق الحَسَنة، ويجتنبوا الأخلاق السيِّئة؛ ليكونوا أمثلةً صادقة وواقعة في دنيا الناس، ثم عليهم أن يفهموا سننَ الله تعالى في الخلق، ثم تكون دعوتهم للناس على علم وبصيرة، وبأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن.
المقال السابق المقال التالى
أضف تعليق