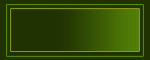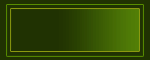- من هو محمد رسول الله؟
- السيرة النبوية
- نبوءات بظهور الرسول
- رسالة لمن لايؤمن برسول الله
- الرسول زوجا
- أصحاب الرسول
- كيف تتبع رسول الله
- انصر نبيك وغض بصرك
- شبهات و ردود
- معجزات الرسول
- نحن و الرسول
- قرأنا لك عن رسول الله
- مدح رسول الله
- أطفالنا على خطى رسول الله
- أخبار الموقع
- اصدارات الموقع
- شاركنا في حملات الموقع
- إنضم إلينا
| تحت قسم | أعمال القلوب | |||
| الكاتب | زغلول النجار | |||
| تاريخ الاضافة | 2015-12-29 20:54:02 | |||
| المشاهدات | 921 | |||
|
|
|
|
ساهم فى دعم الموقع |
|
{وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} [الفجر:1- 4].
هذه الآيات القرآنية الأربع جاءت في مطلع سورة الفجر، وهي سورة مكية، وآياتها ثلاثون (30) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لاستهلالها بالقسم بالفجر (وقتا وصلاة).
ويدور المحور الرئيسي لهذه السورة المباركة حول عدد من ركائز العقيدة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن كل السور المكية، وأشارت سورة الفجر كذلك إلى عدد من صور العقاب الذي نال أمما سابقة كانت قد كفرت بأنعم ربها فعاقبها الله تعالى جزاء كفرها، كما ألمحت إلى بعض الأحداث المصاحبة ليوم القيامة، وإلى ما سوف يتبعه من بعث، وحشر، وحساب، وجزاء، وخلود إما في الجنة أو في النار.
واستعرضت السورة عددًا من طبائع النفس الإنسانية في كل من حالات الرخاء والشدة، واستنكرت عددًا من أمراض تلك النفوس التي قد تكون سببا في خسرانهم في الدنيا والآخرة، وأوضحت أن من سنن الله تعالى في خلقه سنة الابتلاء بالخير والشر فتنة.
وتبدأ هذه السورة المباركة بقسم من الله تعالى بالفجر، وهو زمانا يمثل الفترة التي يبزغ فيها أول خيط من الشفق الصباحي على جزء من سطح الأرض، فيعمل ذلك على محو ظلمة الليل بالتدريج حتى شروق الشمس، ويبدأ الفجر الصادق عندما يكون الجزء من سطح الأرض الذي يبدأ عنده هذا الوقت في وضع بالنسبة إلى الشمس تكون فيه وكأنها على بعد 18.5 درجة تحت الأفق، وتظل الشمس ترتفع في حركتها الظاهرية حول الأرض (والتي تتم بدوران الأرض حول محورها أمام الشمس) إلى أن تظهر الحافة العليا للشمس عند الأفق فتشرق الشمس، وأول ما يصل إلى الأرض من الجزء المرئي من ضوء الشمس هو الطيف الأحمر، وتليه بقية ألوان الطيف المرئي بالتدريج حتى يُرى نور النهار ببياضه المعهود.
ووقت صلاة الصبح هو من طلوع الفجر الصادق من جهة الشرق، وانتشاره بالتدريج حتى يعم الأفق.
وظاهرة الفجر تدور مع الأرض في دورتها اليومية حول محورها أمام الشمس، فتنتقل من منطقة إلى أخرى بانتظام حتى تمسح سطح الأرض كله بالتدريج.
ووقت الفجر يصاحب عادة بقدر من الصفاء والنقاء البيئي الذي قد لا يتوافر لأي وقت آخر من أوقات اليوم، ولذلك فإنه يتميز بالنداوة، والرقة، والهدوء والسكينة، وينعكس ذلك على الإنسان وعلى غيره من مختلف الخلائق، ومن هنا كان القسم الإلهي بالفجر، والله تعالى غني عن القسم لعباده.
ويلي القسم بالفجر قسم آخر يقول فيه ربنا تبارك وتعالي: {وَلَيَالٍ عَشْرٍ} وهي الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفيها ليلة القدر التي أنزل الله تعالى القرآن الكريم فيها، ولذلك يصفها بأنها ليلة مباركة: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} [الدخان: 3] وبأنها خير من ألف شهر: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر:3]، ووصفها رسول الله صلي الله عليه وسلم بقوله الشريف: «ليلة خير من ألف شهر، من حُرِم خيرها فقد حُرِم» (صحيح الجامع: 55)، وقوله: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» (البخاري: 2014).
وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في سواها، وسن لنا سنة الاعتكاف فيها، فكان يعتكف فيها حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه وصحابته من بعده.
ويأتي في مقابلة الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة الذي وصفه الرسول صلي الله عليه وسلم بقوله: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة» (السلسلة الضعيفة: 1193)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة ما نصه: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام قالوا: يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلي الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشئ من ذلك» (سنن أبي داوود:2438).
وعن أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلي الله عليه وسلم: «صيام عاشوراء، والعشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة» (ضعيف النسائي: 2415).
من كل ما سبق يتضح لنا أن الله تعالى قد خص الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك بأن جعلها أشرف عشرة ليالي في السنة، وجعل أشرفها على الإطلاق ليلة القدر، كما جعل أشرف عشرة أيام (بمعنى النهار) هي الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، وجعل أشرفها على الإطلاق هو يوم عرفة، ولما كان الوقوف بعرفات ينتهي مع غروب الشمس كان المقصود بالأيام العشرة الأولى من ذي الحجة هو نهار هذه الأيام، والعبادة فيها مركزة بالنهار بدليل أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصومها في غير أداء لفريضة الحج، ولذلك استحب أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة (أي لغير الحاج).
من هنا كان الاستنتاج الصحيح بأن المقصود بالقَسَم في سورة الفجر بالليالي العشر هي الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وليست الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة أو من شهر المحرم كما رأى بعض المفسرين.
وجاء بعد ذلك قَسَمٌ ثالثٌ (بالشفع والوتر)، والشفع: هو الزوج، والوتر: هو الفرد من كل شيء، وقيل إن المقصود بذلك هو الصلاة، ومنها الصلاة الثنائية والرباعية (الشفع)، ومنها صلاة المغرب وختام الصلاة في آخر الليل (الوتر)، وقد يكون المقصود بالقَسَم الإشارة إلى خلق كل شيء في زوجية كاملة (من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان) وتفرد الله تعالى بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.
ويأتي بعد ذلك القسم الرابع الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالي: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ}، وأصل (السري) هو السير بالليل، وإسناد ذلك الفعل إلى الليل قد يكون من المجاز بمعنى (الليل الذي يسري فيه)، وحذفت ياء الفعل (يسري) من قبيل التخفيف وصلا ووقفًا.
وقد لا يكون ذلك مجازا حيث يشير القسم إلى حركة ظلام الليل على سطح الأرض مما يحقق تعاقب كل من الليل والنهار على سطح الكرة الأرضية بسبب كرويتها، ودورانها حول محورها أمام الشمس، ومن ثم تنتقل ظلمة ليل الأرض من جزء إلى جزء آخر من سطحها كان يعمه نور النهار، وهذه هي حركة ظلام الليل في زمن الليل (أو سري الليل)، وتعاقب الليل والنهار على سطح الأرض هو من ضرورات جعلها صالحة للعمران، ومن هنا كان القسم الإلهي بالليل إذا يسر.
وبعد القسم بهذه الآيات الأربع، وبما لكل منها من قيمة كبرى في انتظام حركة الحياة على الأرض جاء السؤال التقريري: {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ} أي لذي لب وعقل وبصيرة، والمشار إليه باسم الإشارة بهذا الاسم من أسماء الإشارة (ذلك) في الآية الكريمة هي الأمور الأربعة المقسم بها، وجواب القسم محذوف، وتقديره أن الله تعالى بالمرصاد لكل كافر ومشرك وظالم، ولكل متجبر على الخلق ومفسد في الأرض، وليعذبن كل واحد منهم بما يستحق، ودلالة ذلك الاستنتاج هو المتابعة في الاستشهاد بمصارع كل من عاد وثمود وآل فرعون، وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالي: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . إِرَمَ ذَاتِ العِمَادِ . الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي البِلادِ . وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ . وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ . الَّذِينَ طَغَوْا فِي البِلادِ . فَأَكْثَرُوا فِيهَا الفَسَادَ . فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ . إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} [الفجر: 6- 14].
ثم انتقلت الآيات في سورة الفجر إلى وصف شيء من طبائع النفس الإنسانية في حالات السعة والضيق في الرزق، وما فيها من ابتلاء للعباد، وتذكر أن العبد الصالح يشكر النعمة، ويصبر على المحنة، والطالح تبطره النعمة، وتضجره المحنة لأنه يرى في الأولى تكريما لشخصه فيصيبه شيء من الغرور والكبر، ويرى في الثانية إهانة لكرامته فيصيبه الكثير من الهم والحزن، وترد الآيات بأن العبد الذي لا يرضى بقضاء ربه هو مخلوق أناني، لا يفكر إلا في ذاته، فلا يكترث بإكرام اليتيم، ولا بالتحاض على إطعام المسكين، وجل همه النهم الشديد في اقتسام الميراث، والحب الجم للمال أيا كان مصدره من حلال أو حرام.
وهنا تذكر الآيات بالقيامة وأهوالها، ومنها دك الأرض دكًا شديدًا، إشارة إلى تدمير الكون الحالي كله، ثم إعادة خلق أرض غير أرضنا، وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ومن هذه الأرض الجديدة التي سوف تحتوي كل الأرض القديمة، سيبعث الخلائق، ويعرضون أمام ربهم لا تخفي منهم خافية، والملائكة مصفوفون بين يدي الله تعالي، ثم يؤتى بجهنم في هذا الموقف العصيب، موقف الحساب الذي يتقرر فيه مصير كل فرد من الخلق إما بالخلود في الجنة أبدا ، أو في النار أبدا وحينئذ يتذكر الانسان ما فرط فيه في حياته الدنيا ويتمنى لو أنه كان قد قدم شيئا ينفعه في هذا الموقف من حياته الآخرة، وفي حياته الآخرة، فيندم أشد الندم ساعة لا ينفع الندم، ولا تجدي الحسرات! وفي ذلك تقول الآيات: {فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ . وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ . كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرِمُونَ اليَتِيمَ . وَلاَ تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ المِسْكِينِ . وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّماً . وَتُحِبُّونَ المَالَ حُباًّ جَماًّ . كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكاًّ دَكاًّ . وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفاًّ صَفاًّ . وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى . يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} [الفجر:15- 24].
وبعد ذلك تصف الآيتان (25، 26) من سورة الفجر هول عذاب الله تعالى للكفار والمشركين، وللطغاة المتجبرين على الخلق والمفسدين في الأرض فتقولان: {فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ . وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ} [الفجر: 25، 26].
والضمير في كل من الكلمتين: عذابه، ووثاقه إذا نسب إلى الله تعالى كان من معاني الآيتين الكريمتين أن أحدا لا يعذب كعذاب الله سبحانه وتعالى للكفار والمشركين، ولا يوثق كوثاقه لهم، وإذا نسب الضمير للمعذبين فهمت الآيتان على أن أحدا من الخلق لا يُعَذَب في الدنيا كعذاب الكافر والمشرك في الآخرة، ولا يمكن أن يُشَد وثاقه في الدنيا كما سيشد في الآخرة، تهويلا للأمر وتفزيعا للعصاة المتجبرين على الخلق.
وفي المقابل يسمع نداء الحق تبارك وتعالى على أصحاب النفوس الساكنة، المطمئنة بالإيمان بربها، وباليقين بما وعدها من نعيم الآخرة فتختم هذه السورة المباركة بقول الحق تبارك وتعالى:
{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً . فَادْخُلِي فِي عِبَادِي . وَادْخُلِي جَنَّتِي} [الفجر:27- 30].
من ركائز العقيدة في سورة الفجر:
1. الإيمان بالله تعالى ربا واحدا أحدا، فردا صمدا، بغير شريك ولا شبيه، ولا منازع، ولا صاحبة ولا ولد، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لا يليق بجلاله، واليقين بأنه تعالى يحصي عمل كل إنسان إحصاءً دقيقًا، ويجازيه عليه جزاءً عادلا.
2. التصديق بكل ما جاء بالقرآن الكريم، ومن ضمن ذلك ما أخبر به من عقاب عدد من الأمم البائدة، جزاء كفرها أو شركها، أو مظالمها وتجبرها على الخلق، وإفسادها في الأرض، وكان من هذه الأمم أقوام كل من عاد وثمود وفرعون، وجاء ذكرها للاعتبار بما حدث لها.
3. التسليم بقضاء الله وقدره تسليما كاملا، والرضا به، وذلك لأن النفوس غير المؤمنة بالله تعالى يركبها الغرور إذا ابتليت بشيء من السعة في الرزق، وتسول لأصحابها أنهم قد أوتوا ذلك عن جدارة شخصية، واستحقاق ذاتي، وتنسيهم أن ذلك من أفضال الله تعالى عليهم التي تستوجب الشكر، وإذا ابتليت بشيء من الضيق في الرزق سولت لأصحابها أن ذلك من قبيل الإهانة لها، وليست ابتلاء واختبارا للصبر أو للجزع.
4. اليقين بحتمية القيامة وأهوالها وما فيها من تدمير كامل للكون، وبحتمية كل من البعث بعد هذا التدمير، والحشر، والحساب، والجزاء، وبحقيقة الخلود في الجنة أو في النار.
5. التسليم بأن ما جاء في الآية الكريمة رقم (23) من هذه السورة المباركة هو من آيات الصفات الخاصة بجلالة الله تعالى والتي يجب الإيمان بها كما جاءت من غير تشبيه، ولا تكييف ولا تمثيل، ولا تأويل، ولا تعطيل.
6. الإيمان بعالم الملائكة، وأنهم خلق من نور، مفطورون على طاعة الله تعالى وعبادته، وتسبيحه، وحمده، وشكره بلا انقطاع.
7. التصديق بأن عذاب الله تعالى للكفار والمشركين، وللعصاة الظالمين، المفسدين في الأرض، والمتجبرين على الخلق، وشد وثاق كل منهم في الآخرة لا يدانيه عذاب آخر.
8. الإيمان بالمناداة على الصالحين من خلق الله تعالى في يوم القيامة للدخول في زمر عباد الله الصالحين إلى جنات النعيم.
من ركائز العبادة في سورة الفجر:
1. ضرورة المحافظة على الصلوات الخمس وعلى صلاة الفجر على وجه الخصوص (الصلاة الوسطي).
2. الاجتهاد في العبادة خاصة في الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك (وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر).
3. الحرص على إكرام اليتيم، والحض على طعام المسكين.
4. تحريم الظلم بصفة عامة، والظلم في توزيع المواريث بصفة خاصة حيث قد يصاحب بحرمان أحد المستحقين من حقه، أو بالجور على نصيبه، والتحذير من أكل المال الحرام في جميع المعاملات المالية.
5. ضرورة الاجتهاد في الدنيا من أجل النجاة في الآخرة.
من الإشارات العلمية والتاريخية في سورة الفجر:
1. القسم بكل من الفجر (وقتا وصلاة) وبالليالي العشر الأواخر من رمضان، وبالشفع والوتر أي الزوجية والإفراد في الصلاة وفي غيرها من العبادات أو على الإطلاق، وبسير الليل أي بزحفه على سطح الأرض ليتحقق بذلك تبادل الليل والنهار وهو من ضرورات استقامة الحياة على الأرض.
2. التأكيد على احترام العقل الذي يضبط النفس ويحكم السلوك.
3. ذكر عدد من الأقوام البائدة (من مثل أقوام كل من عاد وثمود وآل فرعون) وذلك بشيء من دقائق أوصافهم، وطرائق إبادتهم بظلمهم، والكشوف الآثارية الحديثة تؤكد صدق ذلك كله.
4. التأكيد على أن للكون مرجعية في خارجه إشارة إلى الخالق سبحانه وتعالي.
5. الإشارة إلى شيء من طبائع النفس الإنسانية.
6. الجزم بحتمية تدمير الكون.
وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها، ولذلك فسوف أقصر الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى على القسم بالأشياء الواردة في النقطة الأولى من القائمة السابقة فقط.
المقال السابق المقال التالى
أضف تعليق