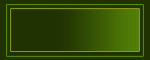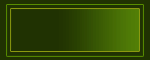- من هو محمد رسول الله؟
- السيرة النبوية
- نبوءات بظهور الرسول
- رسالة لمن لايؤمن برسول الله
- الرسول زوجا
- أصحاب الرسول
- كيف تتبع رسول الله
- انصر نبيك وغض بصرك
- شبهات و ردود
- معجزات الرسول
- نحن و الرسول
- قرأنا لك عن رسول الله
- مدح رسول الله
- أطفالنا على خطى رسول الله
- أخبار الموقع
- اصدارات الموقع
- شاركنا في حملات الموقع
- إنضم إلينا
| تحت قسم | السيرة النبوية صور تربوية وتطبيقات عملية - محمد مسعد ياقوت | |||
| تاريخ الاضافة | 2011-09-03 04:53:31 | |||
| المشاهدات | 2260 | |||
|
|
|
|
ساهم فى دعم الموقع |
|
ثَانِيَ اثْنَيْنِ
"إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ، إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ، إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى، وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" [التوبة:40].
***
يا ويح مكة ! لم تعد صالحة للدعوة، فالوثنية متأصلة، والجهل مستحكم، والتخلف متجذر، وهذا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بُعث فيهم منذ سنوات، فكان عندهم قبل الرسالة الصادق الأمين، وبعد بعثته قالوا : الساحر الكذوب، إذن لابد من أرض جديدة، وبيئة أخرى، وأناس آخرين، فكان الأمر بالهجرة إلى يثرب، فخرج ثاني اثنين، ومكث في الغار ثاني اثنين، وسافر ثانين اثنين، ودخل المدينة ثاني اثنين . إنها غربة الدعوة والداعية .
***
وما أعظم هذه المنقبة لأبي بكر – رضي الله عنه –التي تضاهي الجوزاء في عليائها، والشعرى في مكانتها.. هذه العتيق الذي صلى خلفه النبيُ – صلى الله عليه وسلم - .. كان ثاني اثنين في الغار، وثاني اثنين في المشورة، وثاني اثنين في العريش، وثاني اثنين في القبر .
قال حسان – رضي الله عنه – يرثي الصدّيق – رضي الله عنه - :
إذا تذَكَّرْتَ شَجواً مِن أخِي ثِقَةٍ فاذكُرْ أخاكَ أبا بكر بما فَعـلا
التَّالِيَ الثَّانِيَ المحمودَ مَشــهدُهُ وأوَّلَ الناسِ مِنهمْ صَدَّقَ الرُّسُلا
وثانيَ اثنينِ في الغارِ المُنيفِ وقد طاف العدُوُّ بهِ إذْ صَعَّدَ الجبَـلا
وكان حِبَّ رسولِ اللِّهِ قد عَلِموا خَيْرِ البريَّةِ لم يَعدِلْ به رَجُـلاَ
***
كانا في غار الهجرة، كما كانا دومًا في الغار الأكبر مكة أبان العهد الوثني . ويثّبت اللهُ القلبين المؤمنَين، في الصاحبين المهاجريَن، في الجبل والغار الموحشين. وضربَ أبو بكر – رضي الله عنه - المثل في الإيثار والتضحية، إذ دخل الغار قبل صاحبه، فكسحه، وهيئه، وسد أجحاره، ليأمنْ عقاربه وحيّاته، وكان يقطع من ردائه ليسد هذه الثقوب، وقد أوشك الرداء على النفاد، فقد قطَّــعه فداءَ رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – قطعةً قطعة، ورقعةً رقعة، وبقي ثقبان؛ فألقمهما رجليه، وما هذا عن حمق، بل عن حق، وعن حب وصدق، بل لا يبالي بشيء مادام يكلأ خيرَ البرية . ويُلدغ الصدّيق، فيَحبسَ أنفاسه فورًا، قبل أن تخرج الآه فتزعج صاحبه، وتقطع عليه نومته، بيد أن الدمعة السخينة أبت إلا أن تخترق الجفنين المطبقين، كما ينفجر الينوبع في الصخرة، وسالت العَبرة، من أصل قلب عظيم يتلوى ألمًا، وهي، أي الدمعة، لما خرجت كأنما فرحت، لا لفرحة الخروج، إنما لأنها علمت أن مستقرها فوق أطهر وجه، وجه رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فكانت تلك الدمعة، وصلةُ التنبيه بين قلبين كريمين، فاستيقظ صاحب القلب الرحيم، وإذا به يبادله رقة برقة، ولهفة بلهفة، وقَطرة بقطرة، ولكنَّ الأخيرة كانت من ريقه – صلى الله عليه وسلم -، لتنزلَ على ساقِ أبي بكر فتبرأ بإذن الله. فصَدق الله: " ثَانِيَ اثْنَيْنِ "، وهذا النص يُوحي إليك أنهما روحٌ واحدة في جسدين، أو حياةٌُ واحدة في شخصين، يخاف أحدهما على صاحبه أشد من خوفه على نفسه، الإيثار والحب والأخوة ليست معانٍ نظرية بينهما، بل هي وشائج طبيعية، بل هي أطرافٌ كالأصابع والأيادي والأرجل، وليست هي أعضاءَ لجسد من الجسدين، بل هي مكونات هذه الروح الواحدة التي بين جنبيهما .
***
ولما كان هذا الإيثار، وهذا الحب، وهذه الأخوة، كان أبو بكر – رضي الله عنه – صاحب الريادة والسيادة، في السبق والصحبة، ونال وسامًا خالدًا أن ذكره الله تعالى وذكر صحبته، فقال : "إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ "، فهي شهادة لا تعدها شهادة، ودليل من الله على صحبته أبي بكر للنبي – صلى الله عليه وسلم – في السيرة وفي المسيرة، وفي الجهر وفي السريرة، وكانت دومًا هذه الشهادة تلطم وجه من ينكر فضل الصدّيق – رضي الله عنه – الذي " أَعْطَى وَاتَّقَى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى " .
***
ولما أراد الله أن يصور الهجرة، ويسجلها في كتابه، لم يسجل ذلك المشهد الذي استقبل فيه الأنصارُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – استقبال الزعماء الفاتحين، وهو سيد الفاتحين ، إنما صور القرآن موقف النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو في الغار، في أحرج المواقف، وفي أصعب المشاهد، التي نرى فيها عناية الله تكتن رسول الله – صلى الله صلى الله عليه وسلم – وكأنما دخل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى كِسر بيت تحت عرش الرحمن لا في جوف غار. . "إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ..."
وهذه الآية نزلت في عام العسرة في ثنايا التجهز لموقعة تبوك في شهر رجب من العام التاسع للهجرة، نزلت توبخ القاعدين وتحفز المجاهدين شأنها شأن سورة التوبة كلها، فكان لسان الحال : إلا تنصروا النبي بالخروج معه لقتال الرومان فقد نصره الله من قبلُ !
وفي أي موضع نصره ؟ وما الموضع الذي ذكره الله تعالى في الآية ؟ هل ذكر بدراً فقال :" فقد نصره الله في بدر" – وهو يوم الفرقان العظيم - ؟ لا . هل قال : " فقد نصره الله في الأحزاب " – يوم تكالب أهل الأرض على الإسلام - .. لا ، لم يذكر ذلك، ولم يذكر الفتح المبين في صلح الحديبية، ولم يذكر الفتح الأكبر في مكة؛ بل ذكر الفتح الأول، والهجرة الشريفة، والنصر المنسي، والمعركة التي دارت رحاها بين الله وحده وبين معسكر الوثنية، وما هي أرض المعركة ياترى ؟ لم تكن في ميدان من ميادين القتال المعهودة، بل كانت كهفًا ! نعم هناك كانت المعركة، حيث اجتمع أهل الوثن من حول الكهف يقتفون الأثر، ويعلنون المكافئة، وقد رصدوا الجائزة لمن يأتي بمحمد – صلى الله عليه وسلم -، فطلبوه في كل مطلب، وبحثوه في كل مبحث، حتى وصلوا إلى الكهف، حيث حمي الوطيس دون سيوف ورماح، وعلا غبار الحرب دون قتال كالقتال، في تلك المعركة الدائرة، بين جبار السموات وجبابرة الأرض ..
هنالك تتجلى القدرة الإلهية، وتهطل العناية الربانية، وتتكاثف سحائب الرحمة، فتظلل على خير البرية، هو وصاحبه، إذا هما في الغار، والمشركون محدقون بالمكان، ولو نظر أحدهم أسفل قدميه لانكشف الأمر، ولقُتلَ الإسلامُ بقتل مَن في الغار، ولكن أبى الله أن ينظروا هذه النظرة، وها هي يد الله تمسك بأحداق المشركين ! وها هي قدرة الله تتحكم في ألحاظ البشر أجمعين .
***
وكان رد النبي – صلى الله عليه وسلم – لصاحبه؛ رد الواثق الثابت الصابر : لا تحزن، لاتعبأ، لا تبالي، خفض عنك .. إن الله معنا .
واهاً لتلك النفس التي تكالب عليها البشر، السانح والبارح، والغادي والرائح...، ...، - بيد أن الله معه !
إذنْ لا شيء ضده ! لا شيء يصده !
إن الله معنا. كلمة الإيمان التي خرجت من قلب سيد المؤمنين .
"ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟".
إنه نبينا، يلقي ذلك الدرس على قوبنا، وفي هذا الظرف، من جوف الكهف، أن القلوب وأن العيون بيد الله، يقلّبها كيف يشاء .
هذه الأحداق التي لو تحركت قيد أنمله لكان الإسلام في أَسر الشرك.
وقد وَقع البصر على البصر، بيد أن الله جعل بينهما عجاجة من البلور، أو سدًا، يُرى ظاهره من باطنه، ولا يُرى باطنه من ظاهره .
" فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ " .. سبحان القادر ! كيف تقر السَكِينَةُ في غار موحش، احتوشته جلاوزة الباطل ! إنها سكينة ليست كأي سكينة، إنها منسوبة إلى الله، سكينته، هو، وحده، هو، سكينة منه، بموصفات من عنده، وبسمات من لدنه، فالموقف جلل، والأمر خطر. أتُراك تترك أنسانًا في نقب غائر في جبل مهجور، في صحراء، يقاسي الجوع والظلماء، والعقارب والحيات، يطلبه القاصي والداني من الأعداء، وما يدري أيتيه الموتُ من لذغة حية أو لسعة عقرب، أو مِن ضربة سيف أو طعنة خنجر ! ؟ لو جمعتَ له وسائل التسلية وضروب التلهية وأدوية التهدئة ما سكن قلبه طرفة عين، فما بالك بمن مكث في هذا الغار ثلاثة أيام ! لذا كانت سكينة الله، وكانت جنود الله – التي لم نرها ولم نعرفها -، وذلك ليخرج الداعية من غاره بحفظ الله، ولتمضي دعوة الله في طريقها، وينتشر الإسلام، وتعلو كلمةُ الله العليا .
***
ربٌ حافظ، ثم داعية وصاحب، ثلاثيةٌ لا تقوم لها شيءٌ . والله عزيز حكيم.
***
حكمة :
الأخوة التي في شدة الغار، أقامت دولة عاش أبناؤها في رخاء .
مبادرة :
اهجر المعصية، ومكانُها وزمانُها . ولا تمر بأهلها إلا داعيًا .
تفكُر :
اذكر فضلَ رسول الله عليك – صلى الله عليه وسلم – إذا حبس نفسه في الغار وهاجر .. من أجل أن تصل الدعوة إليك.
توصيات عملية :
1ـ لا تحزن، إن الله مع الداعي إليه
2ـ "ما ظنك باثنين الله ثالثهما "، استشعر دومًا مراقبة الله، وقل في نفسك : الله ناظري، الله رقيبي، الله مضطلع علي.
المقال السابق المقال التالى
أضف تعليق