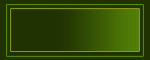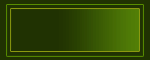بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن الله تعالى الخالق العليم والمدبِّر الحكيم يختار ما يشاء من الأمر والخلق، ويُفَضِّل ما يشاء عمَّا يشاء، من القرآن الكريم[ ] والآي الحكيم، ومِن سواه من الكلام، فقد فضَّل القرآنَ على سائر ما أنزل من الكتب على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وفضَّل من سُوَرِهِ بعضَها على بعض، كما فضَّل سورة الفاتحة[ ] على غيرها من السور، وفضَّل آية الكرسي على ما سواها من الآيات البينات، وفضَّل من الذكر[ ] والدعاء والاستغفار بعضَهُ على بعض، كما في أحاديثَ كثيرة منها: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لِلَّهِ»، ومنها: «سيد الاستغفار[ ] أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوءُ لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب[ ] إلا أنت» (البخاري[ ] ؛ صحيح البخاري[ ] ، برقم:[ 6306]).
وهكذا فَضَّل بعضَ الأشخاص على بعض، حتى الأنبياء فاضَلَ بينهم، كما في قوله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ} [القرة:253]، وقوله تعالى: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} [الإسراء:55]. وفضَّل من الليالي ليلة القدر[ ] : {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ}[القدر:3]، ومن الأيام في الأسبوع يوم الجمعة[ ] : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة[ ] ، وفيه أخرج منها»(مسلم في صحيحه، برقم:[ 854])، وفي السَّنَة يوم الحج[ ] الأكبر: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَرَّ»(الألباني[ ] ؛ صحيح الجامع، رقم:[1064]). وفضَّل البقاع بعضَها على بعض، وأفضلُها على الإطلاق البلد الأمين: «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أُخْرِجْتُ منك، ما خرجت»(أحمد؛ المسند، رقم:[18715]).
وإنّ مما خصَّ الله سبحانه بمزيد فضل من بين الشهور؛ الأشهر الحُرُم، والتي ذكرها الله تعالى في كتابه: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}[التوبة[ ] :36].
أما الأشهر الحُرم التي ذُكِرت في بداية السورة نفسها: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ}[براءة:2]؛ فهي الأشهر التي أمْهَل اللهُ تعالى فيها المشركين، ومنع المؤمنين من قتالَهم، وتلك فرصة لهم ليتوبوا من شركهم وينتهوا من حربهم، فإذا انتهت هذه الأشهر، فقد حلَّ قتالُهم، كما قال تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [براءة:5]، وهي أربعة أشهر مرة واحدة متتابعة، وليس لها علاقة بذات الأشهر المعينة، وإنما ابتدأت بيوم إبلاغهم بها في الحج إلى تمام هذه المدة، بدليل أنها لم تبدأ من بداية ذي القعدة، فقد بدأت من يوم النحر عشر ذي الحجة؛ حيث أذَّن فيهم أبو بكر رضي الله عنه، ففيها: عشرين يومًا من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشرة أيام من ربيع الآخر، وهي ليست كلها من الحُرم، وقرأها عليهم في منازلهم، وقال: لا يَحُجَّنَّ بَعد عامنا هذا مشركٌ، ولا يطوفَنَّ بالبيت عُريان.
فالأشهر الحُرُم الواردة في هذه الآية، والمقصودة بالكلام هي الأشهر ذات الحرمة الأبدية، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» (البخاري في صحيحه، رقم:[ 3197])، فهي ثلاثة سرد وواحد فرد. وقد ضل التلاعب بها ونقلها حتى عادت في ذلك اليوم إلى موضعها الأول؛ حسن تدبير من الله لرسوله، وإتمامًا للنعمة.
وهذه الأشهر ورِثَت العرب حُرمتَها وتعظيمَها، فكانت تُعَظِّمها، فتُحَرِّم فيها القتال، وهو مما ورثته من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. غير أن العرب كانت تقوم معيشتهم على الحروب والثارات والغارات، فكانت تضطر إلى الحرب، فكانت تحتال على هذه الأشهر الحُرُم، فتؤخِّر تحريم الشهر هذا إلى آخر: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [براءة:37]، وربما حرَّمت شهرًا حلالا وأحلت شهرًا محرمًا، وقد تجد نفسها جعلت السنة ثلاثة عشر شهرًا، خلافًا لما خلق الله تعالى عليه السَّنَة، ولذلك جاء في الآية: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ}، فهي منذ خلق الله تعالى السماوات والأرض جعلها اثني عشر شهرًا لا ثلاثة عشر شهرًا، ثم بين أن: {مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ}، وهي التي ذكرناها، وما زال خَلَفُهم من المشركين إلى يوم الناس هذا يؤمنون بحرمات فيقدسونها، ثم ينتهكوا حرمتها، ويحلونها عامًا أو طوْرًا، ويحرِّمونها عامًا، كما يفعلون بأشياء كثيرة؛ حسب أهواءهم.
ففيم تتمثل حرمة هذه الأشهر الأربعة؟!
إن الله تعالى جعل لهذه الأشهر حرمة لحِكَمٍ جمَّة، وجعل لتحريمها صُوَرًا عديدة:
ففي الآية الكريمة، بعد أن بيَّن الله تعالى أن عِدة الشهور عنده في كِتابِ اللَّهِ يعني اللوح المحفوظ وقيل في قضائه الذي قضى يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ، هي هكذا بخلقه وتشريعه، وأن منها أربعة حرُم؛ قال تعالى: {ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}، فهذا هو الحساب[ ] القائم المستقيم، وهو الدين القيم، أي أن الدين القيم هو الذي وضعه الله تعالى لعباده فيما خلق لهم من الخلق، أو فيما شرع لهم من الأمر، لأنه سبحانه صاحب الخلق والأمر والاختيار: {تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}[الأعراف:54]، {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}[القصص:68]، فإذا اختار شيئًا من الخلق أو الأمر الشرعي؛ فليس للمؤمنين إلا الرضا[ ] باختياره، وإلا فليسوا بمؤمنين: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}[الأحزاب:36]. فإن اختاروا غير ما اختار الله لهم، وحرَّفوا الكلم عن مواضعه، وقدَّموا وأخَّروا فقد وقعوا فيما وقع فيه الذين كفروا، والذي قال فيهم: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [براءة:37]. ويُصبحون في دين ليس بقيم، لأن دين الله تعالى هو القيم، وغيره معوجٌّ منحرف ضال.
ومن حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، لذلك أكّد النهيَ عن الظلم[ ] فيها؛ فقال: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}، والظلم هنا يشمل المعاصي كلها؛ كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات، مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق، وكلها ظلمٌ للنفس، لأنها هي التي تُعاقب بجريرة ما كسبت، ولا يضر اللهَ شيئًا، كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}[يونس:44]، وقال: {وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}[البقرة:57].
والظلم والمعاصي محرمة في سائر الشهور والأيام، ولكن خصَّ هذه الأربعة بزيادة التحريم وتأكيده، وتشديدًا للنهي عما وقعت فيه الكفار من انتهاك حرمتها، لأجل ذلك كانت مضاعفة الجزاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "يريد: تحفَّظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف"[الواحدي؛ الوسيط في تفسير القرآن[ ] المجيد:2/ 494]، وقال قتادة رحمه الله: "إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواهنّ، وإن كان الظلم على كل حال عظيم، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء كما يصطفي من خلقه صفايا"[ابن كثير[ ] ؛ تفسير القرآن العظيم:1/ 148]. ونظير هذه المضاعفة كثير، كما قال تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا}[الأحزاب:30]، لأنهن في حُرمة اكتسبنها من بيت النبوة والعلم، فوجودهن فيها مظنة علمهن بحدود الله تعالى، ومظنة الخشوع[ ] والحضور والاحتراس. ومن ذلك حرمة المسجد الحرام، فمجرد إرادة الظلم فيه يعاقب عليها: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}[الحج:25].
مع التنبيه على أن هذه المضاعفة عامة في كل بقاع الأرض، وليست فقط للمُحرمين بالحج أو العمرة[ ] ، أو ممن كانوا في محيط الحرم، فإن للحرم ذاته حرمة أيضًا، فإذا صادف المسلم اجتماعَُ حُرمتَي الزمان والمكان فقد عظُم أجرُ طاعته وإثمُ مظلمته؛ أضعافًا مضاعفة.
ألا فليحذر المسلم مِن أن يجد نفسه قد حمل من الآثام في أشهر قلائل، ما قد يحمله عتاة العصاة في سنوات! لأجل هذه المضاعفة، كما ينبغي له أن يغتنم هذه الفرصة العظيمة والمنة الكريمة؛ فيجتهد فيها في الطاعة، ويكثر فيها من عظائم الأمور، وليتخيَّر منها أعظمها أجرًا وليملأ بها وقته ويُفرغ فيه جهدَه، فلعله يفوز بأجور السنين أو القرون في قليل من الأشهر. وكل طاعة تضاعَف، وكل مظلمة تُضاعف، ولم يرد دليل صحيح بخصوص عمل معيَّن في هذه الأشهر الأربعة، فيبقى على العموم، وأما أفضلية الصوم فيها، فلم يرد فيها إلا حديث: «صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك»... وهو حديث ضعيف، كما في (ضعيف أبي داوود للألباني، برقم:[419]). بينما جاء فضل بعض الأعمال في بعض الأيام منها، كعشر ذي الحجة، بما فيها عرفة: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟» قالوا: ولا الجهاد[ ] ؟ قال: «ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء»(البخاري في صحيحه، برقم:[969]).
إذن كيف تُعَظِّم الأشهر الحُرم؟
إنه كلما كان العبد لربه أتقى، كان لشعائره أكثر تعظيمًا، كما قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب}[الحج:32]. ومن تعظيمها:
الابتعاد عن المظالم كلها، فلا يظلم ربَّه بأن يشرك معه غيره، في عبادة أو قصد أو رجاء أو خوف أو طمع، فإنه الغني عن العالمين.
ولا يظلم غيره من المخلوقات إنسها وبهيمها، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة[ ] ، وأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم مُحرمًا، فلا تظالموا» (مسلم في صحيحه، رقم:[ 2577]). ومن أعظم الظلم والمعاصي اليوم إطلاق الألسن في أعراض المسلمين، والتسميع بهم عند العَلمانيين وفي فضائياتهم، لمجرد خلافات، ربما كان محلها مجالس العلم[ ] والعلماء، فكما قال النبي[ ] صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «كف عليك هذا وأشار إلى لسانه». قلت: يا نبي الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار[ ] على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»(الألباني؛ صحيح اترغيب والترهيب، رقم:[ 2866]). ولا يظلم نفسه أيضًا، لأنه ليس حرًّا في أن يفعل فيها ما يشاء، وكل معصية يرتكبها فهو ظلم لنفسه، لأنه يوردها مهالك الدنيا[ ] والآخرة هذه المعاصي.
ويُعظِّم الأشهر الحرم بأن يجهد فيها بفعل أنزاع المعروف وأبواب الخير، وليتخيَّر أعظمها، فإنها أكثر من الأوقات، ولا يسعه فعلها كلَّها، فليكن من أولوياتها أولاه بالأجر العظيم، ليزداد عظمة بهذه المضاعفة.
اجعلها مدرسة لك تتعود فيها حبس نفسك عمَّا لا يرضها الله تعالى من الأقوال والأفعال، وحتى الخواطر، وصَبْر نفسك على فعل الصالحات ومصاحبة الصالحين، الذين يدعون ربه: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا}[الكهف:28].
فتعظيم هذه الأشهر يكون بزيادة التقوى[ ] والاجتهاد في العمل الصالح، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدًا في هذه الأشهر، لهو خير مما في سواها، خير لك مما طلعت عليه الشمس مضاعفًا.
فإن قيل ما الحكمة في مضاعفة الوزر والأجر في أربعة أشهر من بين أثني عشر شهرًا؟
قيل: ذلك من رحمة الله[ ] تعالى بالمؤمنين، وحسن تربيته لعباده، والأخذ بأيديهم برحمة وحكمة، فلو أنه سبحانه ضاعف الوزر كامل السنة لربما هلك الصالحون بمضاعفة ما قد يأتون من معصيتهم وظلمهم لأنفسهم؛ إذْ أنه ليسوا بمعصومين، فكان أن جعل الله تعالى الحرمة والمضاعفة خاصة بأربعة أشهر فقط، ليستطيع المسلم شدَّ إزاره والاجتهاد فيها أكثر ما يستطيع، ثم ليكون ذلك دربةً له في باقي الأشهر المخففة، وهكذا إذا اتقى اللهَ تعالى وجاهد نفسه؛ وَجَد نفسه في سائر الشهور متقيًا محترسا متيقظًا، قد صار له ذلك عادة وسجيَّة. قال الماوردي: ليكون كفهم فيها عن المعاصي ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها؛ توطئة للنفس على فراقها مصلحة منه في عباده ولطفاً بهم".
وإن قيل: فما بال الله سبحانه جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض، وحرَّم فيها القتال؟ حتى توارث ذلك عربُ الجاهلية الأولى، فكان الرجل يمر على قاتل أبيه فلا يَهِجْهُ، ولا يقربه بسوء، التزامًا بحرمة الأشهر وتعظيمًا لهنّ؟!
قيل: لقد كانت العربُ تعيش على الحروب والإغارات والنهب والسلب، وكانت تنهكها الحرب، وربما ضاق عليها الأمر بسببها، أو احتاجت فترات استراحة، لتعود بعدها من جديد، فكان ربما صادف تلك الرغبة زمان الأشهر الحرم، فأوقفوا الحرب إلى أن تفوت، وربما لم يصادفها فيحتاجون لهذه الراحة، أو العكس؛ فقد يكونون فيه الأشهر فتثور فيهم ثائرة الحرب، فيقومون بتحويل الأشهر الحرم، فيقدمون ويؤخرون، وذلك قول الله تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [براءة:37].
أما حكمته في شريعتنا، فقد علم الله تعالى دخائل النفوس والتِواءاتها وضعفها، وأنه ما دام هناك حقٌّ وباطل، فإنه لا مندوحة من قيام المعركة بينهما، فكان حل القتال في أشهر كثيرة، بينما حرَّم القتال في بعضها، لأسباب منها- والله أعلم-:
أن مع هذه الأشهر تقام عبادتان عظيمتنا شاقَّتان، بل ركنان من أركان الإسلام، صوم رمضان[ ] ، فكانت حرمة رجب قبله تمهيدًا له، وحج بيت الله الحرام، الذي يأتيه الناس من كلّ فجٍّ عميق، بكل ما تحمله كلمة العمق من عمق! وما يتطلبه من اجتهاد واستعداد، بل هو نفسه جهاد، وهو فرصة النساء[ ] للجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور»(البخاري في صحيحه؛ برقم:[1861]). وقال للنساء: «جهادكن الحج»(البخاري في صحيحه، رقم:[2875])، وكان عمر رضي الله عنه يقول: "شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين"(البخاري في صحيحه، رقم:[1516]). فإذا اجتمع على المؤمنين جهادين شق عليهم أو وفَّت عليهم أحدهما، وقد قال الله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}[المائدة:9]، وقال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج:78].
وهذا يُبَيِّن حكمةً أخرى في الأمن، فإنه إذا استتب الأمن وشاع في الناس؛ فإنه يكون سببًا لإقامة الدين، وإقامة العبادة لله تعالى على وجه أكمل، لذلك كان هذا مما امتنَّ الله تعالى على قريش، واستوجب عليهم شكره وعبادته هو الأمن، فقال: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ}[قريش:1-4]، وقال للمؤمنين: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ}[البقرة:238-239]، وهذه الحرمة للأشهر أيضًا تُوَفِّرُ فراغًا للمرء ينتصب فيه للعبادة والتزود منها، كما قال تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ}[الشرح:7-8].
ومن الحِكم في تحريم هذه الأشهر الأربعة وإيقاف الحرب فيها، إعطاء فرصة للفريقين لتقويم أعمالهم وتصحيح مسارهم، فالمؤمنين لدراسة الوضع، ولإمهال الأعداء، فلعلهم يفكرون في الأمر، ويثوبون إلى الإسلام، فهو خير لهم وللمسلمين من أن تأكلهم الحرب، أو يموت الكفار على كفرهم، فهدايتهم على أيدينا خير لنا ولهم من أن يموتوا على أيدينا، إلا مَن أبَى.
ومن حِكمها أيضًا أن أحد الفريقين بعد طول المعركة وحدتها قد يُقدِّر أن ترك الحرب خير له من الاستمرار فيها، لكن تأخذ العزة، أو يخشى تعيير الناس فيًرمى بالجبن والخوف، فيبحث حوله عن أقرب نقطة زمان أو مكان ليختبئ وراءها، فجعل الله تعالى هذه الشهر الحرم مختبأً لهذه العزة النفسية، ثم قد يجعل الله بعدها من الخير للفريقين ما هو خير لهما من استمرار الحرب، خاصة لمن هم تحت القصف من غير المقاتلين أو الضعفة، أو ممن لا دخل لهم فيها. وكانت العرب إذا سرق فيهما سارق، ولم يعرفوه، ولم يريدوا أن يُحرجوه فإنهم ينادون بالشيء المسروق، ثم يُعَيِّنون مكانًا يتعافون عليه، ثم يأتي كلُّ واحد منهم بليل بحفنة تراب يضعها في ذلك المكان، فيأتي السارق بما سرق فيضعه في ذلك المكان، ولا يدري الناي بذلك الليل مَن وضع التراب ممن وضع التبر، فيرجع المسروق إلى صاحبه ويرتفع الحرج عن السارق! ويروى عن جرير تَنَفَّسَ رَجُلٌ وَنَحْنُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلِّي فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: "أُعْزِمُ عَلَى صَاحِبِهَا إِلَّا قَامَ فَتَوَضَّأَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ، قَالَ جَرِيرٌ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُعْزِمْ عَلَيْهِ وَلَكِنْ اعْزِمْ عَلَيْنَا كُلِّنَا فَتَكُونُ صَلَاتُنَا تَطَوُّعًا وَصَلَاتُهُ الْفَرِيضَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُعْزِمُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى نَفْسِي قَالَ: فَتَوَضَّئُوا وَأَعَادُوا الصَّلَاةَ"[ابن عساكر؛ تاريخ دمشق: ، والمقصود: أن الشرع يراعي النفوس ويرفع عنها الحرج، ليستدرجها إلى جلب المصلحة ودفع المضرة عنها المفسدة، ولا أحرج وأشق من سفك الدماء وزهق الأرواح.
فإن قيل: هل بقيت حرمةُ القتال فيها قائمة في شريعتنا أم لا؟
قيل: لا حرمة للزمان ولا المكان إذا تعارضت مع حرمة الإنسان، لذلك اتفق العلماء[ ] على أنه يجوز القتال فيها، بل يجب لحماية أرواح الناس، حتى فسّر بعض العلماء كابن حجر قوله تعالى: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}، أي: بأن تتركوا قتال من استجوب القتال، لذلك قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ}[البقرة: 217]، فلا بد من دفع الفساد بدفع المفسدين، ولو بقتالهم، وإلا فسدت الأرض ومن عليها: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ}[البقرة:251]..
أمَّا إن لم يُفرض علينا القتال فيها، ففيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه مازال القتال فيهن محرَّمًا ما لم يحصل بتركه مفسدة وضرر من العدو، أو كان جهاد دفعٍ. فالذي يُمنع ابتداء القتال من قِبَل المسلمين، وجهاد الطلب لأجل الفتوحات ونحوه.
أمَّا أن يخدعنا الأعداء، فيتغنَّوْا بمحرمات لإخافة المسلمين من انتهاكها، ثم هم يفعلونها، فحرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة ونفسها، بل ومن زوال الدنيا كلها: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم» (الألباني؛ صحيح الترغيب والترهيب، رقم:[2438])، لذلك قال تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}[البقرة:194].
إن الإسلام دين سلام لا دين حرب، لكنه السلام العزيز، لا سلام الذل والانبطاح، لذلك يجنح للسلم ولو كانت دعوة من عدو. وما يقيمه حربه إلا لإقرار السلام. ولذلك كان السلام في حس المسلم عقيدة، لأنه اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وصفة ومن صفاته العلى، يعتقد ذلك ويتعامل به. والسلام تحية المسلم يفشيها في الناس، وذكر يذكره بعد كل صلاة، وخلق يتخلق به وصفة يتصف بها، ومعيارٌ يقاس به إسلامه، فالمسلم الحق من سلم الناس، جميع الناس من لسانه ويده.
راجعتُ في ذلك: تفاسير: الطبري، ابن كثير، الثعالبي، الطنطاوي، الشعراوي، وبعض كتبا السنة، ودرسا مسموعا للشيخ العثيمين، وبعض القليل من المخزون..