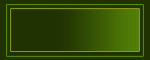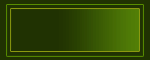- من هو محمد رسول الله؟
- السيرة النبوية
- نبوءات بظهور الرسول
- رسالة لمن لايؤمن برسول الله
- الرسول زوجا
- أصحاب الرسول
- كيف تتبع رسول الله
- انصر نبيك وغض بصرك
- شبهات و ردود
- معجزات الرسول
- نحن و الرسول
- قرأنا لك عن رسول الله
- مدح رسول الله
- أطفالنا على خطى رسول الله
- أخبار الموقع
- اصدارات الموقع
- شاركنا في حملات الموقع
- إنضم إلينا
| تحت قسم | الرحمة فى حياة الرسول _ د/ راغب السيرجاني | |||
| الكاتب | د/ راغب السرجاني | |||
| تاريخ الاضافة | 2012-10-06 14:51:55 | |||
| المشاهدات | 2170 | |||
|
|
|
|
ساهم فى دعم الموقع |
|
عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة, وتعامل مع مشركيها ويهودها سلك نفس المسلك مع كل الصَّدِّ والإعراض الذي وجده منهما، غنه مسلك الرحمة والتسامح والعدل
لقد كان يريد لهم الخير كله على الرغم من جفائهم معه.
موقف اليهود من رسول الله
إن موقف اليهود كان شديد الغلظة مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنهم لم يُفاجَأُوا بظهوره في المدينة, فكل الشواهد تقول إن اليهود كانوا يعرفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة المكرمة, وهو ما رجحه إسرائيل ولفنسون[1] في دراسته عن اليهود -وإن كنا نختلف معه في كثير من الآراء- إلا أن هذا الاستنباط يبدو صحيحًا..
يقول ولفنسون: "ونرجح أن اليهود لم يغفلوا عن الحركة الإسلامية لأنها متصلة بمصالحهم السياسية والتجارية والاجتماعية, خصوصًا إذا لاحظنا اتجاه الدعوة الإسلامية صوب المدينة أواخر سنوات مكة, وميل زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول , ونحن نعلم ما كان بينهم وبين اليهود من الحقد؛ مما جعل زعماء بني النضير وقريظة يراقبون حركاتهم, ثم نعلم أن الإسلام لم ينتشر خفية في يثرب, وكان مصعب بن عمير يدعو الناس إلى الله ورسوله على مرأى من جميع البطون, ثم إننا نعلم أن عددًا من تجار اليهود كان يشترك في مواسم الحج, فمن البعيد أن يجهل اليهود تلك الشئون.."[2].
وأضيف إلى ما قاله ولفنسون أن القرآن المكي صرَّح بأن علماء بني إسرائيل قد عرفوا صدق هذا الرسول .. قال تعالى في سورة الشعراء -وهي سورة مكية -: {أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ} [الشعراء: 197].
فكانت هذه آيةً للمشركين في مكة.. فمعنى ذلك أن المشركين سألوا اليهود عن صفة الرسول فوجدوه في كتبهم, فلا شك أن اليهود قد عرفوا عند ذلك أن الرسول المنتظر هو محمد .
وقد ذكر ابن إسحاق[3] ما يؤيد ذلك, حيث حكى إرسال قريش للنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى يثرب لسؤال أحبار اليهود عن الرجل الذي بُعِثَ فيهم, فدلَّهم أحبار اليهود على عدة مسائل جاءت في التوراة ولا يعرفها إلا نبيٌّ, وبالفعل حمل القرشيان هذه الأسئلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأجاب عنها بما هو في كتب التوراة, وكان هذا الموقف سببًا في نزول سورة الكهف[4], وهكذا وَضُحَ للجميع أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق..
وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ} [الأعراف: 157]. عدة روايات تشير إلى معرفة اليهود بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة مكة المكرمة.
وكل هذه الشواهد تؤكد أن اليهود ما كانوا يجهلون الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته التي جاءت في كتبهم, وأنهم كانوا يتوقعون ظهوره في هذا الزمان, ثم مَرَّت الأيام وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة, ومن أول أيامه هناك حاول أن يتقرب إلى اليهود قدر المستطاع لكونهم أهل كتاب, وإسلامهم ينبغي أن يكون متوقعًا..
إذن كانت هناك خلفية علمية عند اليهود تشير إلى أن هذا وقت نبي آخر الزمان, وكان عندهم علم أن هذا الرسول قد تجمعت فيه الدلائل والمبشرات التي جاءت في كتبهم, ثم إنه يتودد إليهم ويتلطف بهم, ويعتبرهم امتدادًا طبيعيًّا للمؤمنين في حركة التاريخ في الأرض..
ومع كل هذا فماذا كان رد فعلهم لظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
لقد اعترف أقلُّ القليل منهم به , ووقعت منهم مواقف مخزية في الإنكار والإعراض, ومَنْ أشهر هذه المواقف موقفهم من إسلام حَبْرِهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه.. وليس المجال يتسع للتفصيل, وَلْيُرْجَعْ إلى قصته في صحيح البخاري[5].
الشاهد من كل هذا أن الرحمة والتسامح ومحاولات التقرب التي ظهرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوبلت بعدوانية وقسوة من الطرف اليهودي, ومع ذلك لم يكن ذلك مانعًا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مداومة منهج الرحمة والتسامح معهم, وكان أول علامات ذلك ما عقده معهم من معاهداتٍ تحفظ لهم حقوقهم, وتعترف بكينونتهم, وتُقِرُّ بتميزهم واستقلاليتهم عن جانب المسلمين, وتضبط في ذات الوقت أُطُر التعامل –بل والتعاون– في ظل الدولة الجديدة الناشئة..
ومع كل ذلك استمر التكذيب والصد اليهودي, بل ازداد شراسة, ووصل إلى حَدِّ المؤامرات والمكائد, ومع ذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحمتهم بكل وسيلة ممكنة..
ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم معهم أنه كان لا يتعلَّل أبدًا بقسوتهم وظلمهم وصدهم ليبرر به تجنيًا على حقوقهم أو ظلمًا لهم..
منهج رحمة النبي شامل
إن العدل والرحمة في الإسلام أمران مطلقان لا يتأثران بجنس أو لون أو دين, كذلك لا يتأثران بعاطفة معينة, أو بظروف خاصة, فليس هناك مبرر أبدًا للظلم, وكذلك ليس هناك مبرر أبدًا للقسوة.
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90].
ويقول النبي : "مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ"[6]
ويقول أيضًا فيما يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ"[7].
ومن الملاحَظ أن كل هذه الأحاديث جاءت بألفاظ عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين؛ وبشكل واضح لا يحتمل لبسًا في الفهم, ولا سوءًا في التقدير, ومع ذلك فقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع السبيل على كل مسلم في أن يعتقد أن الظلم مسموح به -ولو بدرجة بسيطة– مع غير المسلمين, فقال في كلمات رائعة ما يجب أن نحمله إلى كل إنسان على سطح الأرض ليعلم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا, أَوْ انْتَقَصَهُ, أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ, أَو أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"[8].
هل هناك عدل أو رحمة أعلى من هذا؟!
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا: "اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ"[9].
وفي رواية أخرى لأحمد رحمه الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ"[10].
فهذا تصريح بيِّن أن المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب, ومن هنا فإن المسلم الصادق لا يظلم أبدًا لإحساسه الدائم برقابة الله تعالى عليه, وأن المسألة مسألة عقائدية, وأن الله عز وجل ينصر المظلوم يوم القيامة على الظالم, وإن كان المظلوم كافرًا والظالم مسلمًا, وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف مع المظلوم ضد الظالم يوم القيامة بصرف النظر عن ديانة كل منهما..
هذا هو ديننا لمن لا يعرفه, وهذه هي أخلاقنا التي نعتز بها..
ولم تكن هذه الكلمات الرائعة والمعاني النبيلة مجرد قواعد نظرية لا مكان لها في حياة الناس, بل كان لها الانعكاس الواضح على كل مواقفه وتصرفاته صلى الله عليه وسلم؛ فكان يُبْرِزُ هذا المعنى بجلاء في كل معاهداته وارتباطاته ومعاملاته وقضائه, ويحرص على توفير العوامل المساعدة لإتمامه على أكمل وجه..
روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".
قَالَ الأَشْعَثُ بن قيس[11]: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ, كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ , فَقَالَ لِي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟" قُلْتُ: لا, فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: "احْلِفْ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله صلى الله عليه وسلم, إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي, فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا} [آل عمران: 77] إِلَى آخِرِ الآيَة"[12].
إنه لَموقفٌ نادر حقًّا!!
إنه اختصام بين رجلين.. أحدهما من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر يهودي.. فيأتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما, فلا يجد صلى الله عليه وسلم أمامه إلا أن يطبق الشرع فيهما دون محاباة ولا تحيز, والشرع يُلزم المدعي-وهو الأشعث بن قيس - بالبينة أو الدليل, فإن فشل في الإتيان بالدليل فيكفي أن يحلف المدعى عليه -وهو اليهودي- على أنه لم يفعل ما يتَّهمه به المدعي, فيُصَدَّقُ في ذلك, وذلك مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "البينة على المدعي, واليمين على من أنكر"[13].
ويتأزَّم الموقف عندما يُتبَيَّن أن الصحابي ليس معه بينة, ويصبح الأمر كله رهن حَلِفِ اليهودي, ويشعر الصحابي بخيبة الأمل؛ لأنه يعلم أن اليهودي سيحلف كذبًا دون تردد, فلا يملك له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا, ولا يجد أمامه إلا أن يترك المجال لليهودي!!
ومن جديد نقول إن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلم المدعي لا تدفعه إلى القسوة على اليهودي المُدَّعى عليه!
أليس هذا هو العدل المطلق الذي لا يتوقع أحد من البشر أن يكون له تطبيق في واقع الناس؟! وأليست هذه هي الرحمة التي ليس لها مثيل في حياة الناس؟!
إنَّ هذا ببساطة هو الإسلام.. دين من السماء يحكم حياة الناس في الأرض.
وإنَّ هذا هو رسولنا .. أعظم الخلق خُلُقًا وأدبًا..
إننا لا نملك بعد رؤية أمثال هذه المواقف إلا أن نهتف بقول ربنا: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107].
---------------------------------------------------------------------------------------------
[1] إسرائيل ولفنسون: باحث يهودي حصل على درجة الدكتوراة من مصر تحت إشراف الدكتور طه حسين, وكانت أطروحته تدور حول اليهود في البلاد العربية.
[2] تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام: 106 - 108 بتصرف.
[3] هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار, رأى أنس بن مالك, وروى عن عطاء والزهري, كان صدوقًا من بحور العلم, وله غرائب في سعة ما روى, واختُلِفَ في الاحتجاج به, وحديثه حسن, وقد صححه جماعة. مات سنة 151هـ. انظر: الكاشف 2/ 156.
[4] ابن هشام: السيرة النبوية 1/ 210, 211 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 3/ 98.
[5] البخاري: كتاب الأنبياء (3151), وأيضًا: كتاب الفضائل, باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه (3723), وكتاب التفسير: باب تفسير سورة البقرة (4210).
[6] البخاري: كتاب المظالم, باب إثم مَن ظلم من الأرض شيئًا (2321), كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في سبع أرضين (3023), ومسلم في المساقاة, باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (1612), وأحمد (9663).
[7] ابن ماجة (2320), وأبو داود (3598). وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع: حديث (6049).
[8] أبو داود (3052), والبيهقي في سننه الكبرى (18511) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً, وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع: حديث (2655 ).
[9] أحمد في مسنده عن أنس بن مالك (12571), وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: حسن, وله شاهد بلفظ: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا؛ ففجوره على نفسه, انظر السلسلة الصحيحة (767).
[10] أحمد في مسنده عن أبي هريرة (8781), وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار بنحوه وإسناده حسن. وقال ابن حجر في فتح الباري: إسناده حسن. انظر: فتح الباري 3/360, وكذلك الألباني. انظر: صحيح الترغيب والترهيب (2229), وانظر (3382) في صحيح الجامع.
[11] الأشعث بن قيس الكندي, وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر, وكان من ملوك كِنْدَة, فلما مات النبي ارتد, ثم عاد إلى الإسلام فزوَّجَهُ أبو بكر رضي الله عنه أخته, وشهد القادسية, وشهد مع علي رضي الله عنه صفين. توفي بعد قتل علي رضي الله عنه بأربعين ليلة. انظر أسد الغابة1/ 97, الإصابة, الترجمة (205).
[12] البخاري: كتاب الخصومات, باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (2285), ومسلم في الإيمان, باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (138), وأبو داود (3243), والترمذي (1269), وابن ماجة (2323), وأحمد (3597).
[13] رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (844), والبيهقي (20990), وقال النووي: جاء في رواية "البيهقي" بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعًا: "لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 12/3.
المقال السابق المقال التالى
أضف تعليق