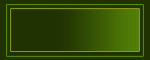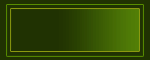- من هو محمد رسول الله؟
- السيرة النبوية
- نبوءات بظهور الرسول
- رسالة لمن لايؤمن برسول الله
- الرسول زوجا
- أصحاب الرسول
- كيف تتبع رسول الله
- انصر نبيك وغض بصرك
- شبهات و ردود
- معجزات الرسول
- نحن و الرسول
- قرأنا لك عن رسول الله
- مدح رسول الله
- أطفالنا على خطى رسول الله
- أخبار الموقع
- اصدارات الموقع
- شاركنا في حملات الموقع
- إنضم إلينا
| تحت قسم | مقالات و خواطر | |||
| الكاتب | عبد العزيز مصطفى | |||
| تاريخ الاضافة | 2012-09-27 15:52:19 | |||
| المشاهدات | 2073 | |||
|
|
|
|
ساهم فى دعم الموقع |
|
قريبًا من أحوال العصر الذي نعيشه اليوم كان العالم محتاجًا إلى حدوث عملية تغيير كبرى عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؛ حيث كان عموم البشر (عربًا وعجمًا) يعيشون صراعات متواصلة، ظاهرها سياسي أو عسكري أو اقتصادي أو اجتماعي، وباطنها ديني واعتقادي؛ إنها كانت حروب أفكارٍ بين عقــول وقلوب، ينحاز كلٌّ منهـا إلى ما يراه مقدسًا وجـديرًا بأن يُفرض على الآخرين.
كانت أمة الروم الكبيرة منقسمة إلى قسمين متخاصمين:
قسم وثني صِرف، يعبد الأصنام على طريقة فلاسفة اليونان والإغريق، وقسم يعبد عيسى -عليه السلام- على أنه إله أو ابن إله، أو ثالث ثلاثة. وكان نصارى الروم أنفسهم على عداوات في ما بينهم، أججتها الخلافات الجوهرية بين الكاثوليك والأرثوذكس الذين تشاركوا في صفات الانحلال والفساد العظيم دينيًا وسياسيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا. وصدَّروا ذلك للبلدان التي سيطروا عليها في الشام ومصر.
أما الفرس -وهم شركاء الروم في إدارة العالم- فكانوا أسوأ حالًا، يقدسون الملوك بدعوى أن دماء الآلهة تجري في عروقهم، ويعبدون النار، فيحرقون بلهيبها الذي لا يخبو كل قيم الهداية والوحدانية التي جاءت بها الرسل. وأما في شرق الأرض فقد كانت الشعوب الصينية على عهد الوثنية البوذية كما هو حالها اليوم، بينما كان الهنود يعددون الآلهة من كل صنف؛ حتى قدسوا البحار والأشجار والأحجار والأبقار، مع إهانتهم للإنسان الذي لا ينحدر من الطبقات العنصرية المختارة، فينزلونه منازل أحط من البهائم.
وفي أطـراف متبـاعدة من الأرض كان اليهود -إلا نفرًا قليلًا- في شتاتهم ينتظرون الخلاص الإلهي، لكن عن طريق إيقاد الحروب بين من سواهم من البشر الأمميين الذين لا يشاركونهم في عبادة الإله الخاص ببني إسرائيل (يهوه).
وأما بلاد العرب -وسط كل هذا- فكانوا في جزيرة تستورد مما وراء البحار حثالات الديانات والأفكار، لتضيفه إلى ما عندها من إرث جاهلي عريق، يُذكَر فينكَر، ما أتاهم لتغييره من نذير ولا بشير.
لقد صدق على سكان العالم وقتها قول الله تعالى في الحديث القدسي: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» (صحيح مسلم برقم 2865).
جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورًا بمواجهة كلِّ هذا الباطل، ومجاهدة كلِّ هذا الفساد الفكري والديني بالوحي المنزل عليه؛ ليعيد البشر إلى العبودية التي تنادي بها الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والتوحيد الذي جافاه ونحاه العبيد، ويردَّهم إلى الصلاح الديني والدنيوي الموصل للفلاح الأخروي. وتلك -بلاشك- مهمة كبرى وغاية عظمى، كانت جديرة بإرسال عشرات أو مئات الرسل في عشرات أو مئات القرى والمدن. لكن الله تعالى اختارلها رجلًا واحدًا من بلد واحد ليستقل بهذه المهام الجسام في الأرض كلها، وهو محمد صلى الله عليه وسلم حيث أمره الله تعالى أن يصدع بما يؤمر، وأن يبلغ ما أنزل إليه، وأن يجاهد بهذا القرآن المنزل جهادًا كبيرًا، يتناسب مع كبر مهمة الهداية، وكبر مسؤولية مواجهة الكفر والغواية، فأنزل عليه:
{وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا . فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا} [الفرقان:51-52].
بين يدي الآية:
كُلِّف النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم دون بقية الرسل برسالة عامة، ليست قومية ولا إقليمية، بل عالمية كونية، لا تقتصر على البلاغ حتى تضم إليه البيان، ولا تنازل الأساطير والخرافات الفكرية الاعتقادية؛ إلا وتواجه معها الانحرافات التشريعية والسلوكية، ولا تكتفي بأمور سعادة الناس في الآخرة، حتى تصلح بالدين دنياهم. وكل ذلك انطلاقًا من بقعة صغيرة من الأرض، مَنْ يعاديه فيها ويحاصره أكثر ممن يؤيده ويناصره، وفي وسط أمة كانت في المؤخرة، ومجتمع لم تكن له مؤهلات أو تطلعات إلى ريادة أو قيادة فيكون عونًا له، بل كان بتفرُّقه وخذلانه عبئًا عليه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم مطالبًا بتغيير هذا الواقع وهو في برج عاجي من أبراج الفلاسفة المنظِّرين، أو صومعة نائية للمتأملين المنقطعين، أو حصن منيع من حصون الملوك المحروسين المتعالين، بل كان عليه صلى الله عليه وسلم أن يغيِّر في أفكار الناس وعقائدهم وهو يعايشهم في مجتمعاتهم، ويغشى مجالسهم، ويمشي في أسواقهم، مؤثرًا فيهم غير متأثِّر بهم، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن في موقف الإلقاء والناس حوله في موقف الإصغاء، كلا؛ بل كان أكثر خواصهم يجادل بالباطل ويغضب له، وعوامهم يهرفون بما لا يعرفون في حمية جاهلية، لا يصبر على معالجتها إلا إنسان مؤيَّد منصور، وهو ما استوجب أن يجتمع في شخصه صلى الله عليه وسلم ما تفرق من مناقب وصفات جميع المرسلين الذين انتُدبوا لمعالجة جميع أدواء الأمم وأمراض البشر، من المرسلين والأنبياء السابقين قبله، فاجتمعت فيه عظيم الصفات والسمات: كثبات نوح، وجسارة هود، وهدوء صالح، وقنوت إبراهيم، وتقوى يوسف، وبسالة موسى، وصبر أيوب، وشجاعة داوود، وفطنة سليمان، وسماحة يحيى، ووداعة عيسى (عليهم جميعًا صلوات الله وسلامه).
ولنا الآن وقفات مع ما في الآية من فقرات:
{وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا}
المعنى - كما أورده الطبري[1]-: ولو شئنا يا محمد لأرسلنا في كل بلد أو قرية نذيرًا ينذرهم بأسنا، ويخوِّفهم من عاقبة الكفر والعصيان، فتخف بذلك أعباء القيام بالرسالة للكافة وحدك، ولكنا حمَّلناك ثقل نذارة الجميع، لتستوجب جميع ما أعد للمرسلين من الكرامة.
وفي تلك الفقرة من الآية، أمور جديرة بأن نجدد بها إيماننا بعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعظمة رسالته، منها:
• أن الله تعالى اختاره من بين الأنبياء، ليكون رسولًا للعالمين مستقلًا بشخصه في تحمُّل أعباء رسالة عامة، لا تخص زمانه ولا مكانه، بخلاف غيره من الرسل، ويدل على هذا مدار سورة الفرقان التي من ضمنها هذه الآية؛ حيث ابتدأت بتقرير عموم الرسالة، وعالمية القرآن. (التحرير والتنوير لابن عاشور)، (تفسير اللباب لابن عادل الحنبلي).
• ومنها: أن الله تعالى جعل عظمة شخصه صلى الله عليه وسلم معادلًا لجميع أشخاص الرسل، الذين كان يمكن إرسالهم إلى جميع القرى في حال لم يرسله هو؛ ولذلك أعطاه من العلم والفهم، ومن القوة والقدرة على التحمل والصبر، ما كان يمكن أن يتحمله عشرات الأنبياء والرسل، في عشرات المدائن والقرى، ولتتوحد الرسالة، ولا تتفرق على ألسنة عشرات الرسل. (في ظلال القرآن لسيد قطب).
• ومنها: أن الله تعالى لما بعثه رسولًا للعالمين، وبديلًا عن كثير من المرسلين؛ كانت له أجورهم جميعًا وأجور جميع من استجاب له إلى يوم الدين من الإنس والجن؛ فثقل بذلك ميزانه وعظمت منزلته وارتفعت درجته، حتى كان جديرًا بالوسيلة والفضيلة، والدرجة العالية الرفيعة. (تفسير البغوي)، (تفسيرأضواء البيان للشنقيطي، الآية 7 من سورة الرعد).
• ومنها: أن رسالته صلى الله عليه وسلم لما كانت لا تخص زمانه ولا مكانه ولا قومه، احتاجت كتابًا غير محدود في مكان، ولا موقوت بزمان ولا مخصوص بنوع إنسان، فجاء هذا القرآن الذي هو أعظم الكتب تشريفًا لمن تنزل عليه، ولمن قام به.
{فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ} [الفرقان:52].
بعد أن بدأت الآية بإظهار عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورِفعَة قدره بالرسالة التي تنزَّلت عليه في القرآن، جاءت بحضِّه على شكر تلك النعمة بأن يجاهد بهذا القرآن، ولا يطيع فيه أهواء الضالين من جميع الأصناف وفي جميع البلاد؛ فالمعنى: إنا فضلناك بالرسالة إلى الكافة، فبلِّغها كافة، ولا تطع في ترك أي شي منها أنواع المبطلين كافة. ونستفيد من هذه العبارة في الآية جوانب عملية مهمة، ينبغي نلحظها في مسيرتنا الدعوية، منها:
• كلما كبرت المنزلة العلمية والدعوية، عظمت المسؤولية، وكلما عظم الطمع في الأجر، تطلب ذلك كثرة المجاهدة. فبعد أن أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعِظَم منزلته في الآية، أعلمه بعظم مسؤوليته، وكلفه بذلك التكليف الكبير. (البحر المحيط لابن حيان).
• الداعي إلى الحق عليه واجبان تجاه دعوات الباطل: الأول: أن يبطلها في نفسه فلا يستجيب لها، والثاني ألا يطيع أصحابها في حرصهم على الكف عن كشف زيفها والدعوة إلى ضدها من الحق. (القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين).
• أصحاب الضلال والهوى يحبون أن يطاعوا في هواهم، ويتمنون ذلك، لكن المطلوب أن نطيع الله فيهم؛ وذلك بمخالفتهم وإبلاغها، بألا نترك إبلاغهم تبعًا لأهوائهم. (تفسير السعدي)، (تفسير البغوي).
• نحن لا نطيع الكفار في ما كان دينًا صحيحًا في الأصل ثم نُسخ؛ فكيف بالباطل المخرِّف والدين المحرَّف الذي كتبوه بأيديهم ويريدون منا أن نقرَّهم عليه؟ بل كيف بما صاغوه من تشريعات وأنظمة أرضية وضعية، وضعوها مضاهاة وضِرارًا للتشريعات الإلهية، ويريدون منا أن نحكم بها ونتحاكم إليها؟ إن ذلك لو حدث لكان شركًا في التشريع، كما قال الله تعالى: {وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} [الكهف:26]، وفي قراءة ابن عامر "فلا تشرك في حكمه أحدًا" (أضواء البيان الشنقيطي، الآية 26 من سورة الكهف).
• الوصف بـ (الكافرين) هنا، دلالة على العلة في الأمر بترك طاعتهم، وهي علة تغطيتهم للحق وجحده، فينبغي الحذر من طاعتهم في القضايا المتعلقة بالاعتقاد؛ لأن من شأنها أن توصِل إلى الكفر إذا استمرت واستُمْرئت، كما قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ} [آل عمران:149]، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إيمَانِكُمْ كَافِرِينَ} [آل عمران:100].
{وَجَاهِدْهُم بِهِ} [الفرقان:52].
هذا خطاب له صلى الله عليه وسلم ومن بعده أهل الدعوة من أمته، باستغراق الوسع في مدافعة الباطل الاعتقادي والفكري بهذا الكتاب المبين وبمنهجه القويم؛ فالضمير في (به) يعود على القرآن كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما- أو يعود على الإسلام كما قال ابن زيد (يراجع تفسير الطبري للآية). والأول أقرب.
ونستفيد من هذه الفقرة من الآية قواعد مهمة في الصدع بالدعوة والمنافحة عنها:
• القرآن الكريم أعظم نعم الله، والجهاد بآياته بعد الاهتداء بهداياته من شُكْر نعمته، والخروج من هجره الذي شكاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، كما ورد في سورة الفرقان نفسها {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} [الفرقان:30]. فمن هجر القرآن هجر الجهاد به، والاقتصار على المقالات والنقولات والنظر العقلي. وكما تقابل نعمة القرآن بالشكر جهادًا به ودعوة إليه، فيجب أن تقابل بالصبر على مشاق تلك الدعوة والأذى في سبيلها.
• المجاهدة في قوله: {وَجَاهِدْهُم} على وزن (مفاعلة) وهي لا تكون إلا بين طرفين يجاهد كلًا منهما الآخرُ: أحدهما هنا يجاهد بالوحي، والآخر يجاهِد بالهوى، فلا ينفك الأمر عن جهاد؛ فمهما تركنا أو أهملنا جهاد أهواء المبطلين بالقرآن، فلن يتركوا هم مجاهدتنا، وسيغزونا بها في عقر دارنا. (التحرير والتنوير لابن عاشور).
• عندما نجاهد بالقرآن، فالأصل الدعوة بالرفق وبالتي هي أحسن. أما المعاند فتنبغي معه المفاصلة والشدة، وإظهار ما جاء به الوحي من أحكام وعقائد ومواعظ، بلا تهيب أو مجاملة؛ فالباء في {وَجَاهِدْهُم بِهِ} للملابسة، والمعنى جاهدهم بالقرآن بإبلاغ آياته والاحتجاج ببراهينه وبأحكامه وعقائده وما فيه من زواجر وقوارع، جهادًا ملابسًا تَرْكَ طاعتهم، وكأنه قيل: فجاهدهم في حال عنادهم بالشدة وبما فيه مما يخالف أهواءهم؛ لا بمداراتهم ومجاملتهم. (تفسير أبي السعود)، (تفسير الألوسي).
• الأمر بالجهاد هنا منصرف إلى جهاد الدعوة والحجة، وهو جهاد اللسان لا السيف -كما هو الظاهر من سياق سورة الفرقان المكية- أما جهاد السلاح فمأخوذ من نصوص أُخَر، والآية تدل على أن الدعوة والمحاجة بالوحي من جنس الجهاد؛ إذ الجهاد نوعان: جهاد دعوة يتضمن إبطال الباطل وإحقاق الحق في الصورة النظرية، وجهاد قتال ينصرف إلى الناحية العملية، وهذا ينقسم إلى جهاد دفع لصد المعتدين على حرمات الله، وجهاد طلب لإزالة بأس الصادين عن سبيل الله. (زاد المعاد لابن القيم: 5/3)، (تفسير ابن أبي زمنين).
• جهاد الدعوة والحُجة والبيان أسبق وأهم من جهاد السلاح والسنان، وهذا - كما قال ابن القيم-: "لعظيم منفعته، وشدة مؤنته، وكثرة أعدائه"، ولأنه لولا قوة الحجة، لما أفادت حجة القوة، ولما أدت شرعة الجهاد مقاصدها من الهداية والإصلاح. ودخول الناس في دين الله أفوجًا، ولأن المجاهد بلسانه يكون جهاده أخوف على نفسه؛ لأنه يكون بين ظهراني من يجاهدهم، وتحت سطوتهم في الغالب. (زاد المعاد: 5/3)، (تفسير البيضاوي).
• من الجهاد بالقرآن تلاوته على المخالف، وهذا يتضمن إيصالًا لمعانيه التي يشترك في فهم معظمها أكثر الناس، لقوله تعالى {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} [القمر:17]، فبلفظه المباشر في الغالب تقوم الحجة وتصل المحجة (تفسير القرآن المجيد لابن عجيبة)، (تفسير إرشاد العقل السليم لأبي السعود)
أما من لا يعرفون لغة العرب، فيبلَّغون بأيسر التراجم الصحيحة للقرآن؛ فالقرآن ألفاظ ومعانٍ، وتلك المعاني تخاطب الفطرة بأي لسان. والوجدان والعقل يُخاطَب بالمعاني قبل الألفاظ.
• المجاهدة بالقرآن تحتاج منا إلى استحضار واستقصاء وبحث؛ فالنص الواحد في القرآن تُكرِّر معانيه وتقررها نصوص قرآنية أخرى، وما لم تظهر معانيه رغم ذلك، تبينه نصوص السنة الصحيحة الموضِحة، فإن لم يَرِد من السنة ما يكفي للبيان؛ كانت أقوال السلف -من الصحابة والتابعين- بيانًا إضافيًا، كما قرر ذلك ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير.
• ضمير الغائب في قوله: {وَجَاهِدْهُم بِهِ} [الفرقان:52].
يعود على أصناف الكافرين الظاهرين، فهم المقصودون أولًا بجهادنا بالقرآن في الآية. وكل باطل يؤول إلى الكفر من الاعتقادات والأفكار القديمة والمعاصرة، يوجد في القرآن رد عليه، علمه من علمه وجهله من جهله، لقوله تعالى: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْـحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ} [الأنبياء:18] (نظم الدرر للبقاعي).
• الأمر بجهاد الحجة والدعوة يوجَّه أيضًا لأنواع المنافقين المتظاهرين بالإسلام -وما أكثرهم- مثلما هو موجَّه لأصناف الكافرين الظاهرين في الكفر، وكلا الفريقين يجاهَدان -في حال عنادهم- بالحجة مع الشدة، كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْـمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} [التوبة:73]، وقوله: {وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا} [النساء:63].
• لا ينبغي أن نقلل من أهمية جهاد المنافقين بالقرآن، فجهادهم - كما قال ابن القيم-: "أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددًا، فهم الأعظمون عند الله قدرًا" وهو "أكبر الجهادين، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين، بل كانوا معهم في الظاهر، بل ربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم، ومع هذا فقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْـمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} (مفتاح دار السعادة:1/70).
• يدخل في جهادنا بالقرآن جهاد أهل الأهواء والبدع الغليظة، وبخاصة الرؤوس منهم، وهؤلاء لا أبلغ ولا أمضى في الرد عليهم من نصوص الوحي المعصوم، ومن تأمل مناظرات ومساجلات وردود الأئمة من أهل العلم على المبتدعة؛ وجد أن ردودهم في الغالب تتفرع عن معاني نصوص الوحي الذي لا حيلة لهم في ردِّه أو تكذيبه.
• ينبغي أن نكون على ذكر بأن الانحرافات الفكرية المعاصرة المنحرفة عن هدايات الرسل، لا تحصين للمسلمين من إضلالها وإغوائها، إلا بنصوص القرآن الحاسمة، ثم نصوص السنة الثابتة؛ شرط أن يكون فَهْم هذه النصوص مأخوذًا عن سلف الأمة؛ فالفكر العَلماني في شقه الشرقي: (الشيوعية والاشتراكية) والفكر العَلماني في وجهه الغربي: (الليبرالية) برأسماليتها في الاقتصاد، وديمقراطيتها في السياسة، وحرياتها المنفلتة في الاجتماع؛ هذه العلمانية بتلوناتها وتقلُّباتها؛ ليس أجدر بكشف زيفها وفضح زيغها أمام المسلمين من القرآن. وكذلك كل الأفكار الوافدة الباطلة وأصول البدع القديمة والمعاصرة؛ في القرآن ردٌّ عليها لمن بحث وتدبَّر، لقوله تعالى: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْـحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذَا هُوَ زَاهِقٌ} [الأنبياء:18] [2].
• كلما كان انتشار دعوة من الباطل أكثر، وكان تأثيرها في إضلال الناس أخطر، احتاجت من العلماء والدعاة إلى جهاد أكبر، وتعيَّن عليهم الصدع بإبطالها على قدر انتشارها، وذلك بتقرير المعاني القرآنية المضادة وتكريرها، أما البدع القديمة التي ماتت ولا تجد من يجاهد بها أو لأجلها، فلا حاجة لمزيد الانشغال بها (إلا للمتخصصين)؛ فالأعمار لا تتسع لأن تُنفَق في الرد على كل المقالات التي كان الشيطان قد أوحى بها إلى من يصغون له.
{جِهَادًا كَبِيرًا} [الفرقان:52].
وصف الجهاد هنا بأنه (كبير) جاء لاعتبارات كثيرة، لا بد أن يستحضرها الدعاة، منها:
• أن جهاد الدعوة لا بد أن يشتمل على شرطي الإخلاص والصواب؛ فالدعوة بلا إخلاص لا تقبل، وهي بلا صواب واتباع لا تجدي. والجهاد بالقرآن لا يكون كبيرًا إلا إذا كان ظاهرًا وباطنًا، (تفسير القرطبي) (تفسير حقي) فلا بد من مجاهدة الباطل بالقلب قبل اللسان أو اليد، كما قال صلى الله عليه وسلم«: فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان» (رواه مسلم، برقم 50).
• وجهاد العلماء والدعاة بالقرآن يكون كبيرًا حين يكون شاملًا للكم والكيف، فيكون شديدًا في ما يستوجب الشدة، وكثيرًا مكررًا في ما يستدعي الكثرة والتكرار. (تفسير الألوسي)، ونصوص الجهاد بالقرآن في مظانها كبيرة وكثيرة في كمِّها وكيفها، ولها قوة دفع خاصة تمكِّن المدافع بها من لجم الخصوم، وجذب المنصفين. (تفسير ابن عاشور) (تفسير الظلال). والآية تدل -كما قال الألوسي-: "على عظم جهاد العلماء لأعداء الدين، بما يوردون عليهم من الأدلة، وأوفرهم حظًا: المجاهدون بالقرآن منهم".
• جهاد أهل العلم والدعوة بالقرآن؛ يكون كبيرًا على قدر ما يترتب عليه من آثار؛ فهو قد فُرِض على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى القائمين بالدين بعده لوظائف عظام، يأتي على رأسها إقامة الحجة على التوحيد، ودحض شبهات الشرك والكفر، والتمكين للحق والسنة، وإبطال مقولات المبتدعة، وتكثير أتباع الحق، وتفريق صفوف الباطل، وكل ذلك وعلى قدره، تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وقد كان جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن محققًا لكل ذلك، فكان جهادًا كبيرًا حقًا؛ لأنه كان مواجهة للعالم في عصره، وظل نبراسًا بعد عصره لكل الهداة المهتدين. (تفسير أبي السعود) (تفسير البحر المحيط).
وقد ضمن الله تعالى بقاء طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سائرة على نهجه في البقاء على الحق علمًا وعملًا، تحصيلًا وإظهارًا، انتصارًا للقرآن، وجهادًا به، وهو ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». (مسند أحمد 22302)..
المقال السابق المقال التالى
أضف تعليق