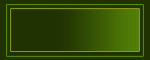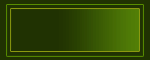- من هو محمد رسول الله؟
- السيرة النبوية
- نبوءات بظهور الرسول
- رسالة لمن لايؤمن برسول الله
- الرسول زوجا
- أصحاب الرسول
- كيف تتبع رسول الله
- انصر نبيك وغض بصرك
- شبهات و ردود
- معجزات الرسول
- نحن و الرسول
- قرأنا لك عن رسول الله
- مدح رسول الله
- أطفالنا على خطى رسول الله
- أخبار الموقع
- اصدارات الموقع
- شاركنا في حملات الموقع
- إنضم إلينا
| تحت قسم | مقالات و خواطر | |||
| الكاتب | أ. د. عمر بن عبدالعزيز قريشي | |||
| تاريخ الاضافة | 2014-01-27 01:05:36 | |||
| المشاهدات | 1594 | |||
|
|
|
|
ساهم فى دعم الموقع |
|
من أخص صفات المسلم أنه يتميز بقلب حي مرهَف ليِّن رحيم، يتجاوب به والأحداث والأشخاص، فيرق للضعيف، ويألَم للحزين، ويحنو على المسكين، ويمد يده إلى الملهوف، وبهذا القلب الحي الرحيم ينفِر من الإيذاء، وينبو عن الجريمة، ويصبح مصدر خير وبر وسلام لِما حوله ومَن حوله. فالمسلم إنسان ذو قلب رحيم؛ لأن مثله الأعلى أن يتخلَّق بأخلاق الله تعالى، وأن يكون له حظ من أسمائه الحسنى، ومن أوضح الأخلاق الإلهية "الرحمة" التي وسِعت كل شيء، وشملت المؤمن والكافر، والبر والفاجر، واستوعبت الدنيا والآخرة، وقد قرب الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه هذا المعنى؛ حيت قدموا عليه مرة بسبي، وإذا امرأة تسعى، قد تحلب ثديها؛ إذ وجدت صبيًّا في السبي، فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟))، قالوا: لا - وهي تقدر على ألا تطرحه - قال: ((فالله أرحمُ بعباده من هذه بولدها))[1]. ومن أبرز أسماء الله الحسنى، اسما: "الرحمن الرحيم"، وهما أشهر الأسماء بعد لفظ الجلالة: "الله"، والمؤمن بالقرآن كلما تلا كتاب الله أو بدأ سورة منه افتتحها بـ: "بسم الله الرحمن الرحيم"، في مائة وثلاث عشرة سورة منه، وحسبنا أن يردد هذين الاسمين في صلاته المكتوبة ما لا يقل عن أربع وثلاثين مرة في اليوم؛ فهو كلما أدى ركعة قرأ فاتحة الكتاب: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: 1 - 3] وهي سبع عشرة ركعة في الصلوات الخمس المفروضة على المسلم يوميًّا، فإذا أدى السنن زاد ضعف ذلك، فإذا رغب في النافلة، زاد ما شاء الله أن يزيد. ولهذين الاسمين الكريمين "الرحمن الرحيم" إيحاءٌ قوي في نفس المؤمن، فضلاً عما توجبه عليه عبوديتُه لله أن يكون له حظ من أسمائه تعالى. والمؤمن يعتقد أنه دائمًا فقيرٌ إلى رحمة الله تعالى؛ فبهذه الرحمة الإلهية يعيش في الدنيا، ويفوز في الآخرة، ولكنه يوقن أن رحمةَ الله لا تُنال إلا برحمة الناس: ((إنما يرحم اللهُ من عباده الرُّحماء))[2]، وكذلك: ((مَن لا يرحم لا يرحم))[3]، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ارحموا من في الأرض يرحَمْكم من في السماء))[4]. ورحمة المؤمن لا تقتصر على إخوانه المؤمنين - وإن كان دافع الإيمان المشترك يجعلهم أَوْلى الناس بها - وإنما هو ينبوع يفيض بالرحمة على الناس جميعًا، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه: ((لن تؤمنوا حتى ترحموا))، قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم، قال: ((إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة))[5]. ومن صفات المؤمنين في القرآن: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ [البلد: 17]، بل هي رحمة تتجاوز الإنسانَ الناطق إلى الحيوان الأعجم؛ فالمؤمن يرحمه ويتقي اللهَ فيه، ويعلم أنه مسؤول أمام ربه عن هذه العجماوات، وقد أعلن النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه أن الجنةَ فتحت أبوابها لبَغِيٍّ سقت كلبًا فغفر اللهُ لها[6]، وأن النار فتحت أبوابها لامرأة حبستْ هرَّة حتى ماتت، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض[7]؛ فإذا كان هذا عقابَ مَن حبس هرة بغير ذنب، فماذا يكون عقاب الذين يحبسون عشرات الألوف من بني الإنسان بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله؟! وقال رجل: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها، وقال: ((إن رحمتها رحِمك الله))[8]. ورأى عمر رجلاً يسحب شاة برجْلها ليذبحها، فقال له: "ويلك! قُدْها إلى الموت قودًا جميلاً"، وهذه الرحمة الدافقة الشاملة أثرٌ من آثار الإيمان بالله والآخرة، ذلك الإيمان الذي يرقق بنفحاته القلوبَ الغليظة، ويلين الأفئدة القاسية". • ولقد غلبت هذه العقيدةُ وهذا الخُلق على أعمال المسلمين الأولين، ووضحت آثارها في سلوكهم حتى مع الأعداء المحاربين، فنجد رسولَ الإسلام يغضب حين مر في إحدى غزواته فوجد امرأة مقتولة فقال: ((ما كانت هذه لتقاتل))، وينهى عن قتْل النساء والشيوخ والصبيان ومَن لا مشاركةَ لهم في القتال[9]، ويسير أصحابه على نفس النهج أبرارًا رُحماء، لا فجَّارًا قساة؛ فهذا أبو بكر - رضي الله عنه - يودِّع جيش أسامة بن ريد، ويوصيهم قائلاً: "لا تقتلوا امرأةً، ولا شيخًا ولا طفلاً، ولا تعقروا نخلاً، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، وستجدون رجالاً فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدَعُوهم وما أفرغوا أنفسهم له"[10]. • ويقول لعمر - رضي الله عنه -: "اتقوا اللهَ في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب"[11]. • "ويحمل إلى أبي بكر - رضي الله عنه - رأس مقتول من كُبَراء الأعداء المحاربين، فيستنكر هذا العمل، ويعلن سخطه عليه، ويقول لمن جاء بالرأس: لا يُحمَل إليَّ رأس بعد اليوم، فقيل له: إنهم يفعلون بنا ذلك، فقال: فاستنانٌ - أي اقتداء - بفارسَ والروم؟ إنما يكفي الكتاب والخبر"[12]. وهكذا كانت الحرب الإسلامية حربًا رحيمة رقيقة، لا يُرَاق فيها الدمُ، إلا ما تدعو الضرورة القاهرة إليه، وقد لاحظ ذلك الفيلسوف الفرنسي "جوستاف لوبون" فقال: "ما عرف التاريخ فاتحًا أعدلَ ولا أرحمَ من العَرَب"[13]. كما برز أثرُ ذلك الخُلق العظيم في العلاقات الاجتماعية الداخلية، فرأينا المجتمعَ المسلم تسُوده عواطفُ كريمة، ومشاعر نبيلة، كلها تفيض بالرِّفق والمرحمة، وتتدفَّق بالبر والخير، وتجلت هذه المشاعر والعواطف فيما عُرف بنظام "الوقف الخيري" عند المسلمين. فقد مضى المواسون من المؤمنين - بدافع الرحمة التي قذفها الإيمانُ في قلوبهم، والرغبة في مثوبة الله لهم، وألا ينقطع عملهم بعد موتهم - يقفون أموالَهم كلَّها أو بعضها على إطعام الجائع، وسقاية الظمآن، وكسوة العريان، وإيواء الغريب، وعلاج المريض، وتعليم الجاهل، ودفن الميت، وكفالة اليتيم، وإعانة المحروم، وإغاثة الملهوف، وعلى كلِّ غرَض إنساني شريف، بل لقد أشركوا في بِرِّهم الحيوانَ مع الإنسان. ولقد تأخذ أحدَنا الدهشةُ وهو يستعرض حجج الواقفين ليرى القوم في نبل نفوسهم، ويقظة ضمائرهم، وعُلو إنسانيتهم، بل سلطان دينهم عليهم وهم يتخيَّرون الأغراض الشريفة التي يقفون لها أموالهم، ويرجُون أن تنفق في سبيل تحقيقها هذه الأموال. ولا شك أن العقيدةَ هي صاحبة الفضل في خَلْق هذه الأحاسيس الرقيقة، وإيقاظ تلك المشاعر السامية التي تنبهت لتلك الدقائق، في كل زاوية من زوايا المجتمع، وكل منحى من مناحي الحياة، ولم يكْفِهم أن يكون برُّهم مقصورًا على حياتهم القصيرة، فأرادوا صدقة جارية، وحسنة دائمة، يكتب لهم أجرها ما بقيت الحياة وبقي الإنسان[14]. نعم لم يجِئْ في القرآن ولا السنة ما جاء في الإنجيل من قول المسيح: "أحبوا أعداءكم... باركوا لاعنيكم، مَن ضربك على خدك الأيمن فأدِرْ له الأيسر... ومن سرق قميصك فأعطه إزارك"[15]. فقد يجوز هذا في مرحلة محدودة، ولعلاج ظرف خاص، ولكنه لا يصح توجيهًا عامًّا خالدًا لكل الناس في كل عصر، وفي كل بيئة، وفي كل حال، مطالبة الإنسان العادي بمحبة عدوه ومباركة لاعنه قد يكون شيئًا فوق ما يحتمله؛ ولهذا اكتفى الإسلام بمطالبته - أولاً - بالعدل مع عدوه؛ فقال -تعالى-: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 8]، كما أن إدارة الخد الأيسر لمن ضرب الخد الأيمن أمرٌ يشق على النفوس، بل يتعذر على كثيرٍ من الناس أن يفعلوه، وربما جرأ الفجرة الأشرار على الصالحين الأخيار، وقد يتعين في بعض الأحوال ومع بعض الناس أن يعاقَبوا بمثل ما اعتدوا، ولا يُعفَى عنهم فيتبجحوا ويزدادوا بغيًا وطغيانًا، وقديمًا قال شاعر عربي:
|
لئن كنت محتاجًا إلى الحِلم إنني
 إلى الجهل في بعض الأحايين أحوجُ
 ولي فرَسٌ للحِلْم بالحِلْم مُلْجَم
 ولي فَرَس للجهل بالجهل مسرَجُ
 فمن رام تقويمي فإني مقوَّمٌ
 ومن رام تعويجي فإني معوج
 وما كنت أرضى الجهل خِدْنًا وصاحبًا
 ولكنني أرضى به حين أُحرَجُ
 |
ولهذا تجلت واقعيةُ الإسلام حين شرع مقابلة السيئة بمثلها، لا حيف ولا عدوان، فأقر بذلك مرتبة العدل، ودرء العدوان، ولكنه حث - بعد ذلك - على العفو والصبر والمغفرة للمسيء، على أن يكون ذلك مكرمة يرغب فيها، لا فريضة يلزم بها، وهذا واضح في مثل قوله -تعالى-: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى: 40]، وكذلك: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: 126]، وكذلك: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: 134]، فتلك عظمة الإسلام[16]. [1] رواه البخاري، كتاب (الأدب)، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ج 4 ص (51). [2] رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: يعذَّب الميتُ ببكاء أهله عليه، ج 1 ص (223). [3] رواه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ج 4 ص (15). [4] رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمين ج 8 ص (111)، وقال: حديث حسن صحيح. [5] رواه أحمد ج 2 ص (165)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج 8 ص (187): إسناده ضعيف لضعف ابن سنان، ولعَنْعنة محمد بن إسحاق، ورواه أبو يعلى، ورجاله وثِّقوا، إلا أن ابن إسحاق مدلِّس. [6] رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب: فضل سقي الماء ج 2 ص (52). [7] رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها ج 2 ص (443 - 444). [8] رواه أحمد ج 5 ص (34). [9] رسالة الجهاد: للإمام الشهيد: حسن البنا ص (89) بتصرف، ط. دار الاعتصام ودار الجهاد. [10] "آداب الحرب في الإسلام" الشيخ محمد الخضر حسين - شيخ الجامع الأزهر الأسبق ص (38)، ط. دار الاعتصام، الثانية، عام (1974)م. [11] المصدر السابق ص (38، 39) بتصرف. [12] "الإيمان والحياة" د. يوسف القرضاوي ص (248). [13] "حضارة العرب"؛ لجوستاف لوبون، ص (126)، ترجمة: عادل زعيتر، ط. عيسي البابي الحلبي، "دار إحياء الكتب العربية". [14] الإيمان والحياة د/ يوسف القرضاوي، ص (248 - 20) بتصرف. [15] إنجيل متى، إصحاح 5، عدد "44" لوقا، إصحاح 6 "27 - 35"، بتصرف. [16] الخصائص العامة للإسلام، د. يوسف القرضاوي ص (149، 150) بتصرف، ط. مكتب وهبة (الثانية)، سنة (1401 هـ - 1981م).
المقال السابق المقال التالى
أضف تعليق